حقيقة التوحيد عند المتكلمين: ردٌّ على تدليس وتلبيس حاتم العوني
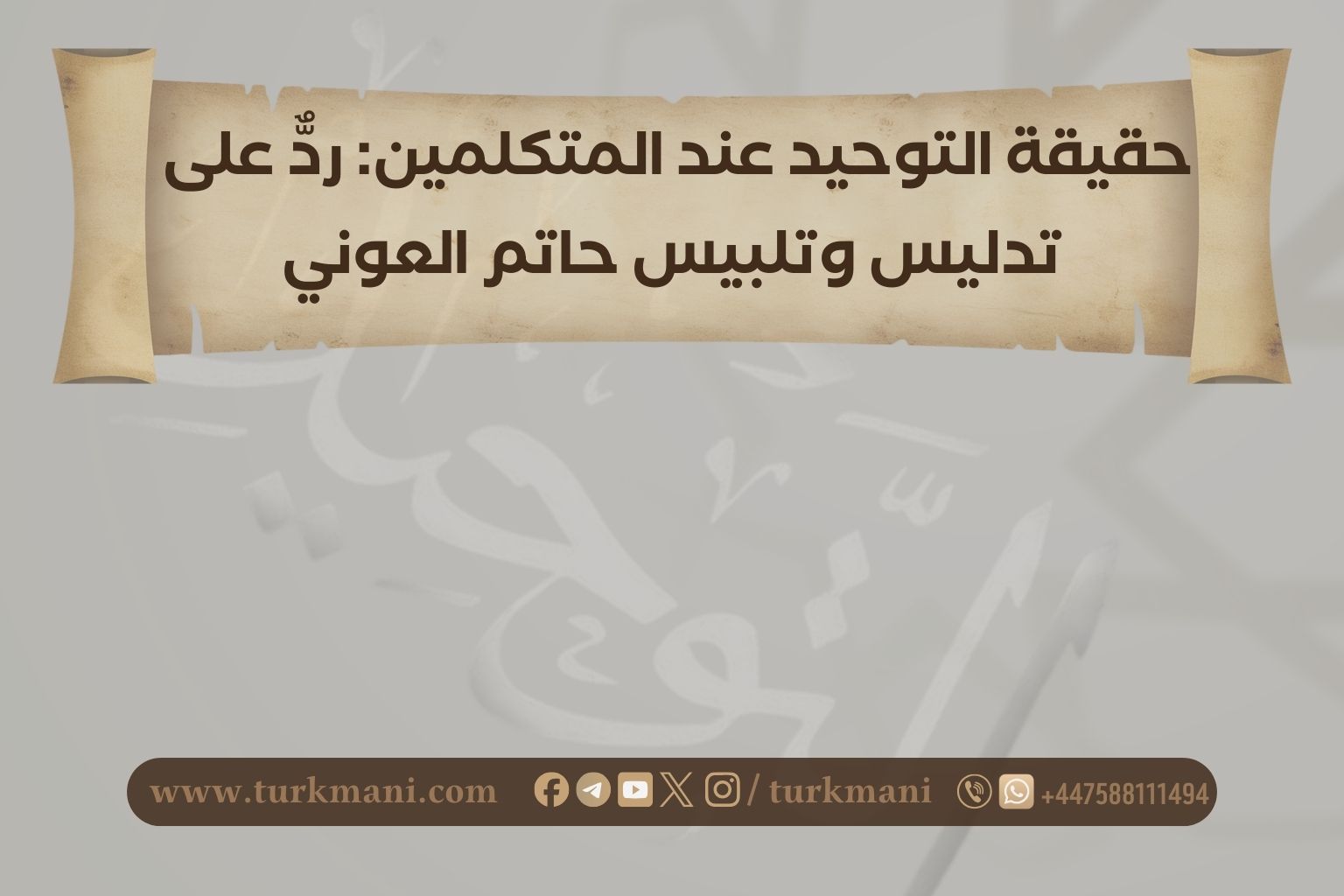
ردٌّ على تدليس وتلبيس حاتم العوني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليُّ الموحِّدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحقِّ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقد وقفتُ على كلمة للدكتور حاتم بن عارف العوني حول (تقسيم التوحيد الثلاثي عند ابن تيمية والتوحيد عند المتكلمين)، زعَمَ فيها أنَّ شيخَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقع في الغلو والمبالغة في الفصل بين أقسام التوحيد الثلاثة، وأن من أسباب ذلك فيما زعم: «هو أنه نسب إلى المتكلمين أنهم ما عرفوا من التوحيد إلا ما عرفه المشركون، وهو توحيد الربوبية، وله عبارات في ذلك صريحة واضحة». ثم ذكر من كلام شيخ الإسلام في ذلك، وعقَّب عليه بقوله: «من الضروري أن أبيِّن خطأ ابن تيمية فيما نسبه إلى المتكلمين، وهذا من باب إنصاف علماء المسلمين، لا ننسى أن المتكلمين هم عامة مفسري القرآن وشراح السنة، من الأشاعرة والماتريدية وحتى المعتزلة». ثم قال: «إن بعض المتعصبين لابن تيمية من السلفية المعاصرة ألفوا عددًا من الرسائل يثبتون فيها عكس ما يقوله ابن تيمية، من تلك الرسائل: توحيد الألوهية عند علماء الشافعية،... عند علماء الحنفية،... عند علماء المالكية، ويقولون عن أئمة المتكلمين أنهم كانوا يقرون بتوحيد الألوهية. فإما كلام ابن تيمية صحيح أو كلام هؤلاء صحيح!». ثم ذكر الدكتور حاتم العوني نماذج من كلام المتكلمين في تقرير توحيد الألوهية، فذكر نقولات عن الفخر الرازي في تفسيره، وعن أبي منصور الماتريدي في تفسيره أيضًا، وعن الراغب الأصبهاني، والبيضاوي، والسيوطي، وغيرهم، كلها تفيد بأنهم فسَّروا لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحقٍّ إلا الله، وأن الإلهية معناها إخلاص العبادة لله تعالى. وبنى على هذا أن القول بأن المتكلمين لم يعرفوا توحيد العبادة غير صحيح، وأن المشكلة في أن ابن تيمية: «لديه مشكلة مع المتكلمين، ومبالغةٌ وحِدَّةٌ في الصراع». ثم دعا إلى (الموضوعية) حتى لا «يغرَّنا كلام ابن تيمية فننسب للمتكلمين خلاف ما يقولون»!
أقول مستعينًا بالله تعالى: هكذا يطعن الدكتور حاتم العوني في علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي عقله وفهمه، وفي عدله وإنصافه، ولا أحتاج هنا أن أذكر شيئًا من كلام علماء الإسلام من معاصري ابن تيمية ومن جاء بعده في الثناء على علمه وعقله، وفهمه وإنصافه، ومعرفته الدقيقة جدًّا بمقالات الفرق ومقاصدهم، فكل ذلك معروف مشهور، لكني سأكتفي بإبطال هذه التشغيبة التي شغَّب بها العونيُّ ليعلم كلُّ منصفٍ مريدٍ للحقِّ أن ما رمَى به العونيُّ شيخَ الإسلام ابن تيمية إنما ينعكس عليه، وأنه متجرِّدٌ من (الموضوعية) مجانبٌ لها، وغاية ما يأتي به شبهات ومتشابهات واعتراضات وتشغيبات جدلية إقناعية خالية من البرهان، يتبيَّن هذا مما يلي:
أولًا: أن كلام ابن تيمية في حق المتكلمين إنما هو في مباحث الاعتقاد، وأصول الدين، وأعلى تلك الأصول وأغلاها: معرفة التوحيد الذي بعث الله تعالى به رُسُله، وأنزل لأجله كتبه، وهو غاية الخلق والتكليف. فبيَّن ابن تيمية ـ في هذا المقام ـ أن المتكلمين لم يعرفوا حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد لله تعالى تأصيلًا وتقعيدًا، فإنهم جعلوا مدار كلامهم في أصول الاعتقاد والديانة في تقرير الربوبية بالأساليب الكلامية، وزعموا أن هذا هو الأصل الأعظم الذي كُلِّف به العباد، لهذا قالوا بوجوب الاستدلال والنظر على طريقة المتكلمين، واختلفوا في صحة إيمان من لم يسلك طريقتهم الكلامية في الإيمان، وهي متعلقة بتقرير الربوبية لا غير.
ثانيًا: لهذا فإن النقولات التي نقلها العوني عن المتكلمين في تقرير توحيد الإلهية والعبادة؛ إنما هي من كتبهم في التفسير أو شرح الأحاديث، لا من كتبهم في الاعتقاد وأصول الدين. ولا شكَّ أن المتكلمين إذا جاؤوا إلى مفصَّل أحكام الشريعة، وتكلموا في معاني الآيات والأحاديث، يقررون توحيد الله تعالى في العبادة. فليس هذا موضع الخلاف معهم، ولو أنهم لم يقرُّوا بتوحيد العبادة لما كانوا مسلمين أصلًا، لكن الخلاف معهم في طريقة تقريره وارتباطه بأصل الاعتقاد والدين.
ثالثًا: يتبيَّن منهج المتكلمين من تصريحهم بجعل توحيد الطلب والقصد والتوجه والطاعة ـ وهو توحيد الألوهية ـ فرعًا لتوحيد الربوبية، وهو المعرفة والتصديق، كما قال الشهرستانيُّ في «الملل والنحل» (مؤسسة الحلبي، القاهرة: 1387، 1/41): «من المعلوم أن الدِّين إذا كان منقسمًا إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة فرع، فمن تكلَّم في المعرفة والتوحيد كان أصوليًّا، ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيًّا، فالأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه».
فنحن نتحدَّى العونيَّ أن يُخرج لنا من كتب «المتكلمين» في (الأصول) وفي (علم الكلام) تقرير توحيد الألوهية والعبادة، وربط ذلك بمقاصد القرآن ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في تعريف العباد بربِّ العباد وأسمائه وصفاته وما يجب عليهم في حقِّه من العبادة التي هي غاية الخلق. لا سبيل له إلى ذلك أبدًا، لهذا رأيناه هنا يفزع إلى نصوصهم ـ التي جمعها الباحثون الذين أشار إليهم ـ من كتبهم في اللغة والتفسير وشرح الأحاديث وأحكام الشريعة التفصيلية.
من نافلة القول أنني أطلق القول بوصفهم بالمتكلمين بناء على ما ادَّعاه العوني، وإلا فإنه استكثر من الأسماء فذكر السيوطي وابن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني والقرطبي المفسِّر والقرافي والحطَّاب، ووصفهم جميعًا بـ: «المتكلمين»، وهذا غير صحيح، فهؤلاء من علماء الشريعة، بذلوا أعمارهم في خدمة علوم القرآن والسنة والفقه واللغة والتاريخ، ولم يكونوا من زمرة المتكلمين أبدًا، لكنَّهم تأثروا بهم بحكم البيئة المدرسيَّة، فوافقوهم في مسائلَ، وخالفوهم في أخرى، وقد عُرف بعضهم بالتحذير من المتكلمين وعلومهم صراحةً، منهم السيوطي في كتابه: «صون المنطق والكلام عن فنِّ المنطق والكلام»، وذكر فيه فصلًا في تحريم الإمام الشافعيِّ رحمه الله النظرَ في علم الكلام!
رابعًا: أكتفي ببيان ما سبق على وجه التفصيل عند الفخر الرازيِّ (ت: 606)، وأبي منصور الماتريدي (ت: 333)، لأنَّهما من المتكلِّمين حقًّا، خلافًا لمن وصفهم العوني بالمتكلمين وهم في الحقيقة من فقهاء الشريعة.
أما الرازيُّ فقد صرح العونيُّ بالنقل من تفسيره، ونحن نعلم أن تفسيره فيه مواضع كثيرة جدًّا صريحة وواضحة في تقرير توحيد الإلهية والعبادة، لا يمكن أن يخفى هذا على طالب علمٍ صغيرٍ، فكيف خَفي على إمام موسوعيٍّ نبيهٍ كابن تيمية؟ الحقيقة أنه لم يخف عليه، لكن كما ذكرتُ؛ كلامُ ابن تيمية معه في مقام آخر، وهو مقام (أصول الدين)، لهذا لم يستطع حاتم العوني ـ ولن يستطيع أبدًا ـ أن ينقض اتهام ابن تيمية للرازي من كتب الرازي في العقيدة، مثل: «تأسيس التقديس»، و«المطالب العالية»، و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين»، و«معالم في أصول الدين»، فكلام الرازي في كتبه هذه مداره على تفسير التوحيد بالربوبية، وجعله غاية المطلوب من العلم والمعرفة.
إن من أشهر كتب الرازي في الاعتقاد وأهمِّها كتابه الكبير: «المطالب العالية من العلم الإلهي»، ذكره ابن أبي أصيبعة (ت: 668) في ترجمة الرازي من كتابه: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (دار مكتبة الحياة، بيروت، 470)، وقال: «ثلاث مجلدات، لم يتمَّ، وهو آخر ما ألَّفَ»، وطبع في تسعة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، بيروت: 1407، عن مخطوطات مصر وتركيا، وذكر المحقق 1/18: «أن المؤلف انتقل إلى رحمة الله تعالى من قبل أن يتكلم في المعاد وفي الأخلاق». فهذا يؤكد صحة ما ذكره ابن أبي أصيبعة من أن هذا الكتاب آخر كتبه، ولم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليغفل عن تقييد هذه المعلومة المهمة جدًّا، فقال في «الفتاوى الكبرى» 6/557: «واعتَبِرْ ذلك بالرازي؛ فإنه في هذه ـ وهي مسألة حدوث الأجسام ـ يذكر أدلة الطائفتين ويصرح في آخر كتبه، وآخر عمره ـ وهو كتاب المطالب العالية ـ بتكافؤ الأدلة». وهذه المسألة في «المطالب العالية» 4/280.
إذا تبيَّن هذا؛ فمقتضى أصول البحث العلميِّ و(الموضوعية) أن نتحاكم إلى كتاب الرازي هذا، ونعدَّه مفسِّرًا لما ذكره في «تفسيره»، فرجعنا إليه، فوجدناه يقول في سياق ردِّه على المعتزلة 9/285: «قال أهل السنة: كلامكم مبني على أن لفظ «الله» معناه: المستحق للعبادة. وهذا باطل. ويدل عليه وجهان: الأول: أَنَّا بيَّنا في تفسير أسماء الله: أن «الله»: اسم علم غير مشتق. الثاني: لو سلمنا أنه مشتق، لكن لا نسلم أن معناه: أنه الذي يستحق العبادة. ويدل عليه وجهان: الأول: أنه لو كان كذلك، لوجب ألَّا يكون إلهًا للجمادات والبهائم، لأنه تعالى يستحق عليها العبادة، ولزم ألَّا يكون إلهًا في الأزل لم يخلق أحدًا، ولم ينعم على أحدٍ فلم يكن مستحقًّا للعبادة. الثاني: أَنَّا بيَّنا أن العقل لا يدل على حصول الاستحقاق. لأنه لا يتفاوت حال المعبود بسبب هذه العبادة وهي شاقة على العابد فوجب ألَّا يحكم العقل بوجوبه. إذا ثبت هذا، فنقول: الإله هو القادر على الاختراع. والدليل عليه: أنه تعالى إنما ظهر الامتياز بينه وبين سائر الذوات بصفته الخَلَّاقيَّة، فقال: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ}، ولما كان المذكور في معرض الامتياز هو هذه الصفة، علمنا: أن معنى الإلهية ليس إلا الخَلاقيَّة».
هذا كله كلام الرازي، ليس من آخر كتبه حسب، بل من الصفحات الأخيرة من المجلد الأخير منه، حيث لم يكتب بعد هذه الصفحة إلا مئة صفحة بترقيم المطبوع، وذكر المحقق في آخره 390 إشارة ناسخ إحدى النسخ الخطيَّة إلى أن الرازي مات دون إتمامه، وأنه وقع الفراغ من نسخه في المحرم سنة (606)، وقد ذكر عامة المؤرخين أنه مات يوم عيد الفطر من هذه السنة نفسها، فقد مات الرازيُّ على اعتقاد: أن تفسير «الإله» بالمستحق للعبادة باطل، وأن الإله هو القادر على الاختراع. أما حججه المتهافتة فلمناقشتها مناسبة أخرى، إن شاء الله تعالى.
لا نحتاج بعد هذا إلى تتبع كتب الرازي في الاعتقاد، فقد قرر هذا في عامة كتبه، وبين يديَّ كتابه: «معالم أصول الدين»، بشرح عبد الرحمن بن عبد الله الخونجي (ت: 638)، طبع حديثًا في مجلد كبير [دار الرياحين، بيروت: 1441]، ذكر فيه «أن إله العالَم واحدٌ» بمعنى توحيد الذات وتوحيد الربوبية كما بيَّنه الشارح 376، وذكر تأويلات المشركين في العبادة فأرجعها كلها إلى اعتقاد الربوبية، وقال الرازيُّ ـ ووافقه الشارح 388 ـ: «واعلم أنه لا خلاص عن هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثِّر ولا مدبِّر إلا الواحد القهار». فهذا مبلغ تقريره للتوحيد في (أصول الدين)!
وأما إقرار الرازي في «تفسيره» بأن الإله هو المستحقُّ للعبادة فلا يناقض هذا المعنى، لأن هذا الاستحقاق ـ عنده ـ متفرع عنه، لهذا قال في سورة الأنعام، الآية (102): «والإله: هو المستحق للمعبودية، فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن الإله عبارة عن القادر على الخلق والإبداع والإيجاد والاختراع». وقال في أول سورة العَلَق: «احتج الأصحاب بهذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى، قالوا: لأنه سبحانه جعل الخالقية صفة مميِّزة لذات الله تعالى عن سائر الذوات، وكل صفة هذا شأنها فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها، قالوا: وبهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هي القدرة على الاختراع. ومما يؤكد ذلك أن فرعون لما طلب حقيقة الإله، فقال: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ}. قال موسى: {رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: 23 - 26]. والربوبية إشارة إلى الخالقية التي ذكرها هاهنا، وكل ذلك يدلُّ على قولنا».
هذه عقيدة الرازي بكلماته، في كتبه المختلفة؛ واطلاعنا عليها يزيدنا قناعة بصحة ما نسبه ابن تيمية إلى بعض المتكلمين، والرازي أحقُّ من يدخل في زمرتهم.
أما المثال الآخر فهو أبو منصور الماتريديُّ، حيث نقل العوني من تفسيره قوله في سورة التغابن، الآية: (13): «لا إله إلا هو، أي: لا معبود إلا هو». وهذا حقٌّ، لكن أين النَّقلُ من كتابه المفرد في أصول الدين، وهو كتاب «التوحيد»، وهو مطبوع مشهور (تحقيق: فتح الله خليف، بيروت: 1970، وتحقيق: بكر طوبال أوغلي ومحمد آروشي، دار صادر، بيروت، ومكتبة الإرشاد، اسطنبول: 2001)؟!
لقد فسَّر الماتريديُّ في كتابه هذا التوحيدَ بتوحيد الذات، وجعل غايته إثبات الصانع على طريقة المتكلمين، وقال (23 طبعة خليف، 89 طبعة اسطنبول): «وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له ـ لا على جهة وحدانية العدد، إذ كل واحد في العدد له نصف وأجزاء ـ؛ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد، إذ في إثبات الضد نفيُ إلهيته، وفي التشابه نفيُ وحدانيته، إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد، وهما عَلَمَا احتمال الفناء والعدم، ونفي التوحيد عن الخلق. والله واحد لا شبيه له، دائم قائم لا ضدَّ له، ولا نِدَّ».
لهذا قرر الماتريديُّ وجوب النظر والاستدلال لمعرفة توحيد الربوبية (135 – 137 ط: خليف).
خامسًا: لقد عُرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالدقة البالغة في كلامه، وتجنُّبه التعميم والإطلاق بغير حقٍّ، وهكذا كلامه في هذا المقام، فقد قال في «التدمرية»: «وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، كما ظنَّه من ظنَّه من أئمة المتكلمين، حيث ظنَّ أن الإلهية هي القدرة على الاختراع». فكلامه هذا صريح بأنه يقصد بعض المتكلمين، لا كلَّهم، فقوله: «من أئمة المتكلمين» يدلُّ على التبعيض؛ خلافًا لما زعمه العونيُّ.
يزيد هذا بيانًا قول ابن تيمية في «النبوات» 1/285: «الإله: هو المألوه الذي يستحق أن يُؤْلَهَ ويُعبد، والتأله والتعبد: يتضمن غاية الحب بغاية الذل. ولكن غلط كثير من أولئك، فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الخلق، وأن الإله بمعنى الآلِهُ، وأن العباد يألههم اللهُ، لا أنهم هم يألهون اللهَ؛ كما ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره».
قوله: «يألههم الله» أي يخلقهم ويوجدهم، وقوله: «يألهون الله» أي يعبدونه ويتذلَّلون له.
وقوله في «درء التعارض» 1/226: «والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنَى القادر على الخلق، فإذا فَسَّر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمة الصفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه؛ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين».
هذا كلام ابن تيمية، وذكر نحوه في «الجواب الصحيح» 3/294، و«الصفدية» 1/148، و«بغية المرتاد» 261، و«بيان تلبيس الجهمية» 3/142، وهو فيه ناقل أمين عن بعض أئمة المتكلمين:
قال عبد القاهر البغدادي (ت: 429) في «أصول الدين» (اسطنبول: 1346/1928، 123): «واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية، وهي قدرته على اختراع الأعيان. وهو اختيار أبي الحسن الأشعري. وعلى هذا يكون «الإله» مشتقًّا من صفة. وقال القدماء من أصحابنا: إنه يستحق هذا الوصف لذاته. وهو اختيار الخليل بن أحمد [الفراهيدي (ت: 170)، وأبو العباس محمد بن يزيد] المبَرَّد [ت: 286]. وبه نقول».
وقال الشهرستانيُّ (ت: 548) في «الملل والنحل» 1/100: «قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريُّ: إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى، لا يشاركه في الخلق غيره، فأخص وصفه تعالى هو: القدرة على الاختراع. قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى: الله».
وقال الشهرستانيُّ ـ أيضًا ـ في «نهاية الإقدام في علم الكلام» (دار الكتب العلمية، بيروت: 1425، 56) ـ في القاعدة الثالثة: في التوحيد ـ: «وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى أن أخصَّ وصف الإله هو القدرة على الاختراع، فلا يشاركه فيه غيره، ومن أثبت فيه شركةً فقد أثبت إلهين».
وإرجاع معنى الإلهية واستحقاقها إلى معنى الربوبية مقرَّرٌ في عامة كتب المتكلمين، ومن أراد معرفة الأثر السيء لتقريراتهم، فليتأمل ظهوره في كلام الإمام البيهقيِّ (ت: 458)، رغم كونه محدِّثًا أثريًّا، وفقيهًا شافعيًّا، لكنه تأثر بمذهب الأشاعرة، فإذا به يقول في كتابه: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» (دار الفضيلة، الرياض: 1427، 59): «الله: معناه من له الإلهية، وهي القدرة على اختراع الأعيان، وهذه صفة يستحقها بذاته».
سادسًا: إذن الخلاف مع المتكلمين ليس في النتيجة النهائية ـ أي: في استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له ـ، فإن هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وإنما الخلاف في معنى «الإله» في نفس الأمر، ومعنى «التوحيد» وحقيقته كما بيَّنه الله تعالى في كتابه، ودعا إليه رسول صلى الله عليه وسلم. فقد خالف المتكلمون منهج القرآن والسنة في هذه الأصول مخالفة كليَّة، وترتبت على ذلك نتائج علمية وعملية خطيرة:
منها: جعل معنى التوحيد مقتصرًا على الإقرار بالربوبية والخالقية وتوحيد الذات والأفعال، ولزم من هذا إخراج توحيد العبادة من أصل مفهوم التوحيد، وجعله فرعًا مترتبًا عليه.
ومنها: إغفال حقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم في إصلاح عقائد الناس وعباداتهم.
ومنها: جعل التوحيد ـ بمفهوم المتكلمين ـ هو أول واجب على المكلَّف، واشتراط النظر والاستدلال عليه. ونتج على هذا خلافهم في صحة إيمان من لم يستدلَّ.
ومنها: أن عقيدة هؤلاء المتكلمين الذي فسَّروا التوحيد بالربوبية والخالقية كانت من أهم أسباب انتشار شرك العبادة بين المنتسبين إلى الإسلام، من الاستغاثة بغير الله، وتعظيم القبور والسجود لها والطواف حولها والذبح والنذر لها. وما جرَّأهم على ذلك إلا اعتقادهم أن هذه الأعمال لا تضرهم ما داموا مقرين بتوحيد الله في الربوبية والخالقية. وكانت ـ أيضًا ـ من أهم أسباب قعود أكثر العلماء عن إنكار ذلك على العامة لأن نشأتهم على تأصيلات المتكلمين سلبتهم الحجَّة في الإنكار، والغَيرة في الانتصار لعقيدة التوحيد، ولم تنفعهم ـ بعد أن انهدمت القواعد والأصول ـ تلك الإشارات المقتضبة إلى توحيد العبادة في بطون كتب التفسير وشروح الأحاديث والفقه.
إن ابن تيمية لمَّا عاب هذا على المتكلمين شرحه وعلَّله حتى يتبيَّن وجه ما ينقم به عليهم، فلا بدَّ من النظر في تمام كلامه حتى يتضحَّ مراده:
قال رحمه الله: «ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهًا مساويًا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملَكًا أو نبيًّا أو كوكبًا أو صنمًا، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملَكَ»، فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنويَّة، الذين يقولون بالأصلين: النور والظلمة، وأن النور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة، فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة، لكنها لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بيَّنه في كتابه، فقال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)} [الزُّمر]، وقال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91)}، وقد قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)} [يوسف]. وبهذا وغيره يُعرف ما وقع من الغلط في مسمَّى «التوحيد»، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولًا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يُقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضًا، وهم مع هذا مشركون. وقد تبيَّن أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله، كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا: إنهم خالقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق، مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطِّل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام»، انتهى النقل من «الرسالة التدمريَّة»، ونحوه في «اقتضاء الصراط المستقيم» 2/286، و«درء التعارض» 1/226، و9/377، وغيرهما.
فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس لعاقلٍ منصفٍ يقرأ كتاب الله تعالى، ويعرف حقيقة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن يُقرَّ بصحته وصوابه، إلا إن كان ممن تلاعبت به الأهواء، واستحكمت على قلبه الشبهات والشهوات.
سابعًا: أَختم هذا الردَّ بشهادة مهمة من القرن الرابع بما أحدثته تقريرات المتكلمين من فتنة وشقاق في المجتمع الإسلامي، سجَّلها إمام كبير من أئمة الشافعية هو أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطَّابيُّ (ت: 388) رحمه الله تعالى، فقد كتب رسالة إلى أحد طُلَّابه عُرفت برسالة «الغُنية عن الكلام وأهله»، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» 2/144 – 156، وفي «درء التعارض» 7/278 – 303، والسيوطيُّ (ت: 911) في «صون المنطق» 137 - 147، وهي طويلة، لا مجال لإيرادها هنا، لكن موضع الشاهد منها أن الخطابيَّ نبَّه على مخالفة المتكلمين لأصل المنهاج القرآني والسُّنيِّ، فقال رحمه الله: «إنَّ هذه الفتنة قد عمت اليوم، وشملت، فشاعت في البلاد، واستفاضت، ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله تعالى، وذلك مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الدين بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»، فنحن اليوم في ذلك الزمان، وبين أهله، فلا تنكر ما تشاهده منه... ثم إني تدبرتُ هذا الشأن، فوجدتُ عظم السبب فيه أن الشيطان صار اليوم ـ بلطيف حيلته ـ يسوِّل لكل من أحسَّ من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء وذهن، ويوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة، واقتصر على واضح بيان منها؛ كان أسوةً للعامة، وعُدَّ واحدًا من الجمهور والكافَّة، وأنَّه قد ضل فهمه، واضمحلَّ لطفه وذهنه. فحركهم بذلك على التنطع في النظر، والتبدع لمخالفة السنة والأثر، ليَبِينوا بذلك من طبقة الدهماء، ويتميزوا في الرتبة عمَّن يرونه دونهم في الفهم والذكاء، فاختدعهم بهذه المحجة حتى استزلَّهم عن واضح المحجة، وأورطهم في شبهات تعلَّقوا بزخارفها، وتاهوا عن حقائقها، فلم يخلصوا منها إلى شفا نفسٍ، ولا قبلوها بيقين علم. ولما رأوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف ما انتحلوه، ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه، ضربوا بعض آياته ببعض، وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته المأثورة عنه، وردوها على وجوهها، وأساؤوا في نقلتها القالة، ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم بالتزيُّد، ونسبوهم إلى ضعف المنة، وسوء المعرفة لمعاني ما يروونه من الحديث، والجهل بتأويله، ولو سلكوا سبيل القصد، ووقعوا عندما انتهى بهم التوقيف، لوجدوا برد اليقين، وروح القلوب، ولكثرت البركة، وتضاعف النماء، وانشرحت الصدور، ولأضاءت فيها مصابيح النور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم».
فهذا طرفٌ مما لمسالك المتكلمين من آثار سيئة، ومفاسد جلية، على عقائد المسلمين، وسلامة فطرهم، وقوة إيمانهم ويقينهم، لعل فيه عبرة وعظة لمن يغفل عن القواعد والأصول، ويُعنى بالنتائج والآثار.
والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه:
أبو مَسْلمةَ عبد الحقِّ التركمانيُّ
في غرة شهر المحرَّم الحرام 1442
[ حمل المقال منسقاً بصورة بي دي اف: ملون - غير ملون ]
- لا يوجد تعليقات بعد
