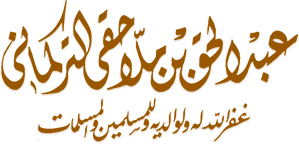تنبيه الإخوان على حال شكيب أرسلان
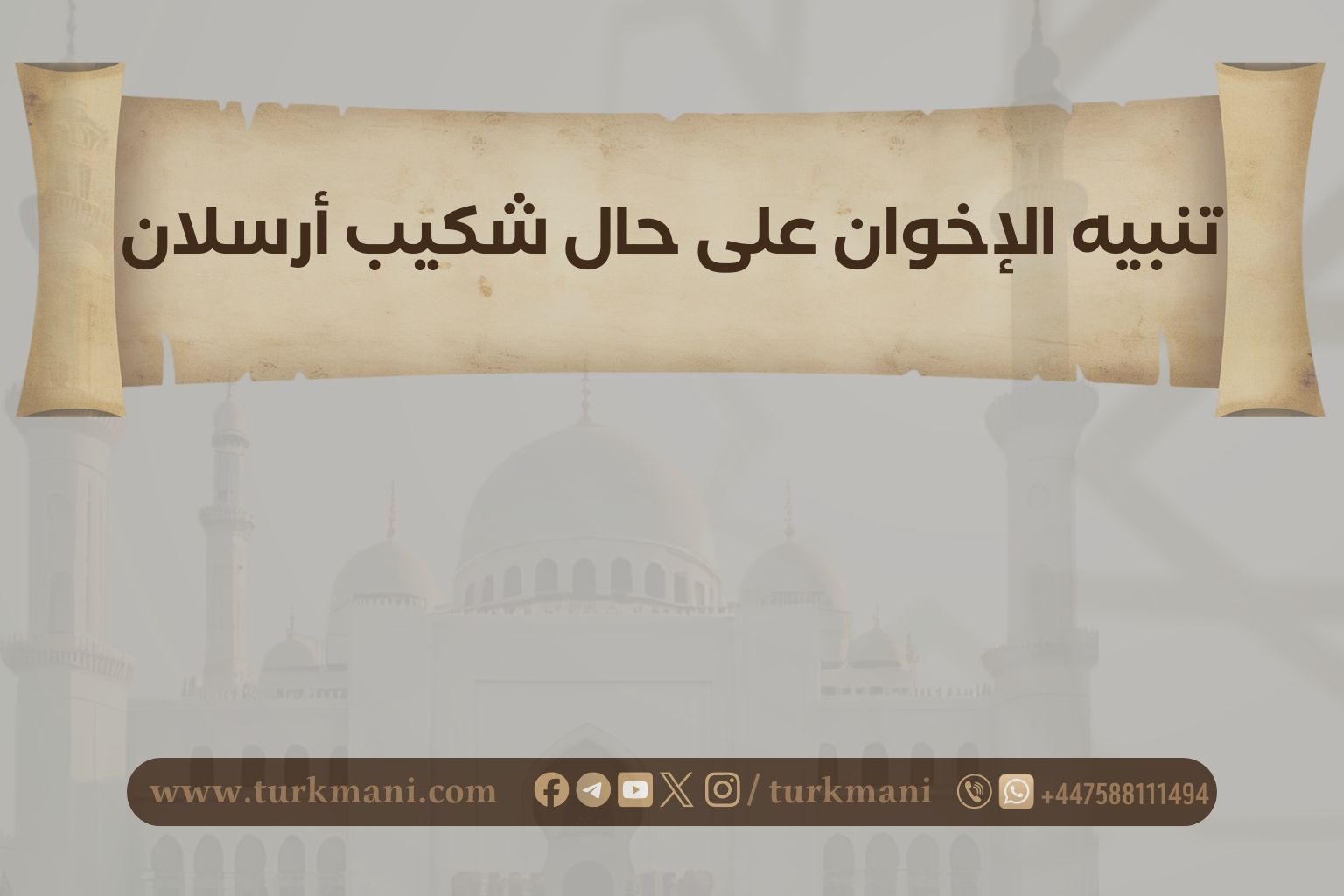
تنبيه الإخوان على حال شكيب أرسلان
أمير البيان شكيب أرسلان (1286 - 1366 هـ = 1869 - 1946 م) من أعلام المسلمين ورجالاتهم في النصف الأول من القرن العشرين، وكان مؤثرًا في مجالات الفكر والسياسة بصلاته بأعيان أهل عصره وبحضوره القويِّ في منابر الكتابة الصحفية، وقد كتب عن نفسه عام 1935 أنه أحصى ما كتبه في ذلك العام، فكان (1781) رسالة خاصة، و(176) مقالة في الجرائد، و(1100) صفحة كُتُبٍ طبعتْ، ثم قال: «وهذا محصول قلمي في كل سنة»! (الأعلام للزِّركليِّ 3/ 173). وكان الباعث لنشاطه الكبير هذا: حماسته المحمودة، وحرصه على وحدة المسلمين وعزِّهم، والنهوض بهم من حال الجهل والضعف والتخلف عن ركب الأمم القوية المتقدِّمة، ومقاومته للاحتلال الصليبي لكثير من بلاد الإسلام مما سُمِّي زورًا بالاستعمار، ومعرفته بمكائد الصهاينة وما يسعون إليه من إقامة دولة لهم في أرض فلسطين.
ولا يمكن معرفة أهمية جهاد شكيب أرسلان إلا بمعرفة أحوال المسلمين في زمانه، فقد عاش في مرحلة من أسوأ المراحل التي مرَّت بها الأمة المسلمة في تاريخها، حيث كان المسلمون في غاية الجهل بأمور دينهم ودنياهم، وكان الغالب عليهم الأُميَّة والفقر والضعف والتخلُّف، وكانت السلطة الدينية النافذة في المجتمعات المسلمة لطواغيت التصوف والدجل والسحر والشعوذة والخرافة، فانتشرت فيهم الاعتقادات المنحرفة، والأخلاق الفاسدة، واستحكمت فيهم حال الجمود والتقليد والتعصب على غير هدًى، وابتعدوا عن روح الإسلام وحقائقه بُعدًا كبيرًا، وسلَّط الله عليهم أعداءهم من الإنكليز والفرنسيين والإيطاليين فاحتلوا أكثر بلادهم، وعاثوا فيها فسادًا، والمسلمون في غفلتهم سامدون!
لقد كان في المسلمين قلَّةٌ من أهل العلم والفكر والقلم أشفقوا على أحوال المسلمين، ونهضوا للتصدي لتلك الأوضاع، وسعوا في الإصلاح والنهضة والتجديد، وقاوموا الهجمات الشرسة لقوى الاحتلال والتنصير والإلحاد.
وكان أولئك القلَّة على درجات متفاوتة في صحة المعتقد والمنهج، وفي العلم بالكتاب والسنة، وفي التدين والاستقامة، وفي السلامة من الأصول الاعتقادية الفاسدة والأفكار العصرية المنحرفة:
فمنهم ظالم لنفسه.
ومنهم مقتصد.
ومنهم سابقٌ بالخيرات.
ومنهم من هو مفارقٌ لهذه الطوائف الثلاث بالكليَّة!
لكنَّهم كانوا ـ جميعًا ـ يتفقون في القدر المشترك بينهم؛ وهو السعي في النهوض بأحوال المسلمين ومواجهة أعدائهم. لهذا نجد أن شكيب أرسلان عندما أخرج كتابه: «لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟» فرح به وأثنى عليه عدد من أعلام عصره، رغم أنهم كانوا على عقائد مختلفة، ومناهج شتَّى، فكان فيهم: السُّنيُّ السلفيُّ، والعقلاني الكلامي، والحداثي العصري، بل كان فيهم النصراني والرافضي، اتفقوا جميعًا على الشكوى من واقعهم المرير، وعلى ضرورة السعي لتغييره وإصلاحه.
فلا بدَّ أن تُفهم شخصية شكيب أرسلان وتُقرأ مقالاته وكتبه في إطار تصور صحيح ومفصَّل عن زمانه، وكذلك في إطار تقييم دقيق وعادل له، فالرجل لم يكن من علماء الشريعة، ولم يكن عنده علمٌ بمفصَّل أحكام القرآن والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه كان مسلمًا متحمسًا غيورًا، حصيلته معرفةٌ تاريخيةٌ عميقةٌ، وثقافةٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ واسعةٌ، وعقليَّةٌ قويَّةٌ في التفكير والتحليل، ممَّا حمله على الكتابة في الموضوعات التي تناولها بمحض فكره ورأيه، بجرأةٍ بالغةٍ، وحماسةٍ شديدةٍ، لهذا وقع في مخالفات صريحة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقرر أصولًا وأفكارًا منحرفة عن هدي الكتاب والسنة.
إن الموقف الشرعي الصحيح من تراث شكيب أرسلان الفكري هو أن يكون مادَّةً لخواصِّ طلاب العلم والباحثين يستفيدون منه في دراسة واقع المسلمين في ذلك العصر ويتتبعون من خلاله نشوء الأفكار العصرية وتطورها، أما عامة المسلمين ـ من المتعلمين وطلاب العلم ـ فتكفيهم «المعرفة المجملة» بأن شكيب أرسلان كان من رجالات المسلمين في ذلك العصر، وكان من أعلام نهضتهم الحديثة، وكان له جهاد مشكور في مقاومة أعداء الإسلام وفضح مكائدهم.
ومن الخطأ البالغ إعادة نشر مقالات شكيب أرسلان وكتبه، والدعاية لها، وتيسير الوصول إليها لعامة القرَّاء، وذلك لأسباب كثيرة، أشير إلى بعضها:
فمنها: أن شكيب أرسلان لم يكن من أهل العلم بالكتاب والسنة وبمُفَصَّل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكان متأثرًا بالأفكار المنحرفة التي راجت في عصره، لهذا تضمَّنت كتاباتُه انحرافات اعتقادية وفكرية خطيرة؛ ففي نشرها إحياءٌ لها، بل وترويج ودعوة إليها، خاصَّةً إن لم يقم الناشرُ بتتبعها والتنبيه عليها والتحذير منها.
ومنها: أن شكيب أرسلان يمثل حلقة من سلسلة تيارٍ منحرفٍ؛ فهو من تلاميذ ابن صفدر الإيرانيِّ ـ الذي يذكره شكيب باسم: «حكيم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني» ـ، ومن تلاميذ محمد عبده، وكان صديقًا لمحمد رشيد رضا.
وهؤلاء الثلاثة يمثلون مدرسة منحرفة في فهم الإسلام والدعوة إليه، وإن كان الأخير (محمد رشيد رضا) قد اهتدى إلى دعوة التوحيد ومنهاج النبوة في سُنَيَّاته الأخيرة.
ومنها: أن أكثر طلاب العلم الشرعي ليس عندهم فهم دقيق مفصَّل بأفكار هذه المدرسة، وما كان فيها من انحرافات خطيرة، وما نتج عنها لاحقًا من أفكار ومناهج وجماعات. فهذه مسالك دقيقة وعرة تحتاج إلى معرفة مفصلة بتاريخ الأفكار، ومقاصد دعاتها، ودلالات المصطلحات وسيرورتها. وأكثر إخواننا من خواصِّ أهل العلم وطلابه تعوزهم الإحاطة بها، فكيف بعامة طلاب العلم، بل كيف بالعامة من المتعلمين والمثقفين والقراء؟
وأضرب لهذا مثلًا بمصطلح «السلفية»؛ فإن أكثر طلاب العلم اليوم إذا وقفوا عليه في «أدبيات» ذلك الزمان يفهمون منه المعنى العلميَّ الشرعيَّ للسلفية، الشائع في عصرنا هذا، وهو: «اتباع الكتاب والسنة في العقيدة والشريعة والسلوك والأخلاق بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الحديث والسنة». ولا يعلمون أن مصطلح «السلفية» كان له ـ في ذلك الزمان ـ مفهومه الخاص عند دعاة الإصلاح والتجديد والنهضة، حيث كان يوصف بالسلفية كل من ينكر بدع الصوفية وخرافاتها، ويدعو إلى ترك التقليد والتعصب المذهبي، ويدعو إلى الاجتهاد والتجديد، وإلى الأخذ بالاختراعات الحديثة والوسائل الجديدة في ميادين التعليم والتمدن والعمران.
فكان وصف «السلفي» ـ بهذا المعنى ـ يشمل من هو سلفيٌّ حقًّا وصدقًا بالمعنى الشرعي المنضبط، ويشمل ـ أيضًا ـ المعتزلي والعقلاني والحداثي، لأنهم كانوا ـ جميعًا ـ ينكرون البدع والخرافات، ويحاربون الطُرُقيَّة والجهل والتخلف، ويسعون في إصلاح أحوال المسلمين.
وإذا عُرف هذا؛ فلا عجب في أن تلك «السلفية» اشتملت ـ أيضًا ـ على إنكار بعض الاعتقادات الغيبيَّة، والتكذيب بأحاديث صحيحة، وإحياء أقوال المعتزلة في بعض المسائل، وتقرير مبادئ عقلانية وليبرالية وعلمانية!
فمن الخطأ البيِّن أن يصف أحدٌ اليوم ـ بعد أن ظهر العلمُ بمفصَّل الاعتقاد وتمايزت المناهج ـ رجلًا مثل شكيب أرسلان بأنه: «كان سلفيًّا»، فإنه لم يكن سلفيَّا بالمعنى الشرعي الصحيح، بل بالمعنى الذي كان شائعًا في عصره.
وليتضح لك حقيقة ما ذكرته في هذه الفقرة والتي قبلها أذكر لك نموذجًا من ثناء الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 1354 / 1935) على شكيب أرسلان، حيث قال: «وأما الأمير شكيب نفسه فهو من أنبغ مريدي الأستاذ الإمام [محمد عبده] الذين تلقوا عنه عقائد السنة السلفية، وحكمتها العالية في بيروت، حيث ألَّف «رسالة التوحيد» التي لم يؤلَّف مثلها في الإسلام، فكان بهذا من أنصار الإسلام والسنة لا من آحاد المسلمين أو عوامهم، وقد قال له السيد جمال الدين ـ حكيم الملة ـ: حيَّا الله أرضَ إسلامٍ أنبتتكَ!». (مجلة المنار، الجزء: 8، مجلد 28، 30 ربيع الآخر 1346 / 27 تشرين الأول 1927).
قال أبو مَسلَمةَ: هذا تخليط عجيب، فقد نسج محمد عبده رسالته في «التوحيد» على أصول عقيدة الأشعرية الكلامية ـ وإن كان لا يتقيد بها تقيُّدًا دقيقًا ـ، وأورد فيها ما يخالف أصول اعتقاد السلف، وقد طبعها الشيخ محمد رشيد رضا، وتعقب شيخه في مواضع منها، من ذلك أن محمد عبده فسَّر «التوحيد» بإثبات صفات الربوبية ـ على طريقة المتكلمين ـ، فعلَّق عليه محمد رشيد رضا بقوله (ص 4): «فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره... إلخ». وتعقَّبه في حقيقة إثبات الصفات: 9، وردَّ عليه في مسألة خلق القرآن ردًّا يُبيِّن خطأ شيخه في تصوير أصل المسألة: 16، وتعقَّب شيخه في تسمية الأشعرية بأهل السنة والجماعة مبيِّنًا أن «هذه التسمية راجت بعلو جاه هؤلاء النظار عند الخلفاء والأمراء وكثرة أتباعهم من العلماء» 18، وتعقَّب شيخه في عدم ذكره للمجدد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية: 22، وصرَّح محمد عبده في الطبعة الأولى لرسالته بخلق القرآن، وعلَّق محمد رشيد رضا بتعليق طويل في إثبات صفة الكلام، وقال 47: «وقد حذفنا من هذا الموضع نحو صفحة من الرسالة في مسألة الخلاف في خلق القرآن عملًا بأمر المؤلف...»! وأحال التلميذُ في مواضع إلى رسائل ابن تيمية في أصول الاعتقاد.
والمقصود: أن محمد رشيد رضا بالغ هذه المبالغة الفاحشة في مدح رسالة شيخه، ووصفها بالعقيدة «السنية السلفية»، رغم أنها مخالفة لأصول عقيدة السلف ومنهاجهم، وقد تنبَّه لذلك رشيد رضا نفسه لما قام على طباعة الرسالة، فعلَّق عليها تعليقات مفيدة، وذلك بعد أن اتصل بعلماء الدعوة الإصلاحية في نجدٍ وعرف العقيدة السلفية وطبع جملة من رسائل ابن تيمية، فحاول التصحيح والتقويم، ولكنه لم يتبرأ من شيخه الضَّالِّ براءةً تبرأ بها ذمَّتُه.
لهذا كلِّه؛ فإنني أرى أنَّ ما أعلن عنه أخونا البحاثة فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ـ وفقه الله وسدَّده ـ من عزمه على نشر جميع مقالات شكيب أرسلان وكتبه؛ غير مناسبٍ، وأن الأولى ـ بل الصحيح الواجب ـ أن تبقى تلك المقالات والكتب على وضعها الأول في بطون الصحف والمجلات، وعلى رفوف المكتبات، فلا يقف عليها إلا خواص الباحثين والعلماء، ولا تكون مبذولة لعامة القرَّاء، وذلك للأسباب التي ذكرتها آنفًا.
وأضيف هنا ذِكْرَ سببٍ آخرَ في غاية الأهمية، وهو: أن نشر تلك المقالات والكتب، وإعادة تداولها وقراءتها، سيؤدي إلى تأثر قليل أو كثير من القراء بما فيها من انحرافات اعتقادية وفكرية ـ مهما حاول الشيخ تخفيفها بتعليقاته ـ، وسيحمل هذا أهل العلم وطلابه على التفتيش في تلك المقالات والكتب عن تلك الانحرافات، والردِّ عليها على وجه التفصيل، فينبري من تأثر بتلك المقولات بالردِّ على منتقديها! وفي هذا فتح لأبواب الخلاف والفتنة والاشتغال بالردود فيما لا طائل تحته، ولا فائدة منه.
لقد قلتُ في مقالٍ قديمٍ لي عن سيِّد قطب: إن أكثر من أساء إليه هو أخوه محمد قطب الذي نشر كتبه، وجدَّد طباعتها على مدى عقودٍ طويلةٍ، وكذلك كلُّ من روَّج لفكره وأطلق الألقاب الفخمة في حقِّه، حتى إنهم وصفوه بالإمام المجدِّد وذكروه مع شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب! ولولا صنيعهم هذا لبقيتْ معرفةُ أكثر الناس بسيد قطب معرفةً «مجملةً»؛ بأنه: «كاتب إسلامي مشهور»، وكفى، لكن إصرارهم على النشر له، والترويج لكتبه وأفكاره، حمل أهل العلم على البحث الدقيق في «مفصَّل» اعتقاداته وأفكاره، فظهرت كتابات كثيرة في بيان ضلالاته وانحرافاته وأخطائه، فكان في صنيعهم أكبر الجناية على سيد قطب، وكان في صنيع من ردَّ عليه من أهل العلم القيامُ بواجب بيان الحقِّ، وردِّ الباطل، والنصيحة لخاصة المسلمين وعامَّتهم، جزاهم الله خير الجزاء.
نعم؛ لن يبلغ الأمر مع شكيب أرسلان هذا المبلغ، لأنه كان كاتبًا مستقلًّا، أما سيد قطب فهو من رموز الحركة الإسلامية وما تفرَّع عنها من تنظيمات سريَّة وعلنيَّة، وقد سخَّرت إمكانياتها العالمية في الترويج لفكره، ومحاربة كل من يكشف عن ضلالاته، ويحذر من انحرافاته.
لا بدَّ أن أختم هذا المقال ببعض الأدلة والبراهين على صحة الدعاوى العريضة التي أطلقْتُها في حقِّ (شكيب أرسلان)، فهذا من حقِّ القارئ عليَّ.
لقد ذكرتُ شُرُوعَ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في نشر مقالات شكيب أرسلان وكتبه، وقد وقفتُ على أول كتاب قام الشيخ بنشره، وهو: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدَّم غيرهم»، تأليف: أمير البيان شكيب أرسلان، قدَّم له ودرسه وشرحه: أبو عُبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، عمَّان: 1445 / 2023؛ فوجدت فيه من الأخطاء ما ينبغي التنبيه عليها، وبالله تعالى التوفيق:
1- كتب الشيخ أبو عُبيدة مقدِّمة للكتاب في (352) صفحة، شحنها بالنقولات المطولة عن البحوث والمقالات المنشورة عن الكتاب وكاتبه، ولم يعتن بتمييز عقائد كُتَّابها ومقاصدهم، فقد أراد كل واحد منهم تفسير كتاب شكيب حسب عقيدته وتوجهه، ووقعت في كلامهم إشكالات كبيرة.
ليس هذا المقال في نقد مقدمة الشيخ، لكني أكتفي بالإشارة إلى هذين العنوانين فيها 253: «شكيب المصلح السلفي»! و338: «لم يكن شكيب سُنيًّا فحسب بل هو سلفي»!
والعجب من فضيلة الشيخ أنه نقل في إثبات هذه الدعوى كلام محمد رشيد رضا في الثناء عليه بأنه تلقى عن محمد عبده: «عقائد السنة السلفية وحكمتها العالية في بيروت حيث ألف رسالة التوحيد»! وقد نقلته بتمامه فيما سبق، ثم إن الشيخ مشهورًا ـ وفقه الله ـ قال في الحاشية عن محمد عبده: «في سلفيته كلام كثير». ثم نقل عن بعض المصادر أن محمد عبده كان يدعي في رسالته بخلق القرآن، ولكن الشيخ رشيد رضا حذف الكلام الخاص بخلق القرآن».
إذن؛ فلا محمد عبده كان «سلفيًّا» ـ بالمعنى الشرعي الصحيح ـ، ولا رسالته في «التوحيد» كانت على طريقة السلف ومنهاج السنة. فهذه الشهادة التي نقلها الشيخ أبو عُبيدة عن رشيد رضا في إثبات سلفية شكيب؛ شهادة باطلة، لا قيمة لها. والشيخ يعلم ذلك؛ فما فائدة أن ينقلها في إثبات سلفيته؟
وسأذكر في آخر هذا المقال ما يثبت أن شكيبًا في غاية البعد عن السلفية ـ بالمفهوم الشرعي ـ.
إنني أخشى أن تحمل هذه المجازفة في إثبات «سلفية شكيب» بعض الإخوة إلى البحث في صحة إسلامه؛ فإنه ـ وإن انتسب إلى الإسلام والسنة وحجَّ إلى بيت الله الحرام ـ لا نعرف عنه براءة صريحة من دين الدروز وعقيدتهم، ولا أستبعد أن يعدَّهم من فرق المسلمين كما عدَّ النصيرية منهم، وقد أخذ منهم شبابًا متطوعين عندما سافر للجهاد في ليبيا!
وإذا كنَّا لا نعلم أن شكيب أرسلان ـ رغم انتسابه للإسلام والسنة ـ قد حاول دعوة طائفته الدروز إلى الإسلام؛ فإننا نعلم اليوم أن سِبْطَه: وليد بن كمال جنبلاط ـ الزعيم السياسي للدروز في لبنان، وأُمُّه هي مَيْ شكيب أرسلان ـ قد صرَّح مرارًا أن طائفته قد خرجت من دائرة الإسلام، ودعاهم إلى «العودة إلى دين الإسلام» (وكلامه منشور بصوته وصورته).
وعندما كتب الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين (ت: 1436) مقاله «الدروز في مرآة بعضهم» في سنة (1430)؛ أخبرني رحمه الله تعالى بتفاصيل ما ذكره في مقاله من دعوة وليد جنبلاط: «المملكة العربية السعودية إلى بذل وسعها في دعوة الدروز إلى الدين الحق»، وأنه زار وليدًا لهذا الغرض، واتفق معه على خطوات عملية لتحقيق هذه الأمنية، لكن شيوخ الطائفة أبطلوا تلك المساعي.
فهل يُعرف شيءٌ من هذا عن شكيب أرسلان؟ مع أن سبطه وليدًا لا يُعرف بالتديُّن أصلًا!
2- قال شكيب في فصل (كون المسلمين الجامدين فتنة لأعداء الإسلام وحجة عليه) 522: «والحقيقة أن هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدنية، وهم الذين يحولون دون الرقي العصري، والإسلام براء من جماداتهم هذه... ولم تكن مقاومة الجديد خاصة بجامدي الإسلام، فقد قاومت الكنيسة في النصرانية كل جديد تقريبًا من قول أو عمل، ثم عادت فيما بعد فأجازته، ولما قال «غاليله» بدوران الأرض كفرته، ولا يزال يوجد إلى اليوم من أحبار النصارى من يكفر كل مخالف لما جاء في التوراة من كيفية التكوين، ومن سنتين حوكم أحد المعلمين في محاكم إحدى الولايات المتحدة لقوله بنظرية داروين ومنع من التدريس، ولكن هذا لا يمنع سير العلم في طريقه. فالنصارى عندهم جامدون كما عندنا جامدون، والمسلم الجامد يحارب كل علم غير العلم الديني التقليدي الذي ألفه...».
قال أبو مَسْلَمةَ: كلام شكيب هنا صريح في وصف «نظرية داروين» بالعلم، وفي ذمِّ من يردُّها باتهامه بالجمود والتقليد؛ نصرانيًّا كان أم مسلمًا! وقد علَّق الشيخ مشهور على هذا الموضع بالتعريف بداروين، وبيَّن خلال ذلك أن نظريته: «أصبحت هراء، ولا يعوَّل عليها من ناحية علمية». لكن الشيخ ـ سدَّده الله ـ لم يبيِّن خطأ شكيب في تقرير أصل المسألة، وأنه أخطأ في وصم من يرفض النظرية بالجمود، وأن كلامه يدل على إقراره بها؛ فيلزم النظر في كتبه ومقالاته الأخرى للتبيُّن من حقيقة موقفه منها. فهذه قضية منهجية ينبغي تحرير القول فيها حراسةً لعقيدة القرَّاء. ولشكيب في «رحلة الحج» كلام آخر في نظرية داروين، ذكر فيه أنها نظرية فيها خلاف ونقد حتى عند علماء الغرب، لكنه لم يصرح بتكذيبها ومناقضتها لعقيدة الإسلام.
3- وقال شكيب في فصل: (حث القرآن على العلم باعث للمسلمين على سبق الأمم في الرقي) 553: «وقد زعم بعضهم أن المراد بلفظة «العلم» في القرآن هو العلم الديني، ولم يكن المقصود به العلم مطلقًا لنستظهر به على قضية تعظيم القرآن للعلم وإيجابه للتعليم. وكل من تأمل مواقع هذه الآيات المتعلقة بالعلم وبالحكمة وغيرها مما يحث على السير في الأرض والنظر والتفكير يعلم أن المراد هنا بالعلم هو العلم على إطلاقه متناولًا كل شيء، وأن المراد بالحكمة هي الحكمة العليا المعروفة عند الناس، وهي غير الآيات المنزلة والكتاب كما يدل عليه العطف، وهو يقتضي المغايرة، ويعزز ذلك الحديث النبوي الشهير: «اطلبوا العلم ولو في الصين»؛ فلو كان المراد بالعلم هو العلم الديني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طلبه ولو في الصين؛ إذ أهل الصين وثنيون؛ لا يجعلهم النبي مرجعًا للعلم الديني كما لا يخفى. وفي بعض الآيات من القرائن اللفظية والمعنوية ما يقتضي أن المراد بالعلم علم الكون؛ لأنه في سياق آيات الخلق والتكوين، وهي في القرآن أضعاف الآيات في العبادات العملية؛ كالصلاة والصيام؛ كقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)} [سورة فاطر] أي: العلماء بما ذكر في الآية من الماء والنبات والجبال وسائر المواليد المختلفة الألوان وما فيها من أسرار الخلق، لا العلماء بالصلاة والصيام والقيام».
قال أبو مَسْلَمةَ: قول شكيب بأن العلم الممدوح المأمور به في كتاب الله يشمل العلم الدنيوي، وأن «الحكمة» في كتاب الله هي الحكمة الدنيوية الإنسانية لا «الآيات المنزَّلة والكتاب»؛ قول باطل لا مستند له، ولم يقل به أحدٌ من السلف وعلماء التفسير، وإنما ابتدعه شكيب وأقرانه، ثم انتشر هذا القول في أدبيات الحركة الإسلامية، ثم تبناه الحداثيون والليبراليون، وتبناه أخيرًا الزنديق الملحد: محمد شحرور وادعى أن آية فاطر في العلم الدنيوي خاصة، وهذا ما يروجه في هذه الأيام تلميذه الصغير الحقير: يوسف أبو عوَّاد!
لقد علَّق الشيخ مشهور على حديث الصين بقوله: «قال أبو عُبيدة: الحديث باطل»؛ لكنه لم يتعقَّب شكيبًا في ادعائه أن المراد بالعلم في القرآن: علم الكون، رغم أنَّ هذا القول الفاسد صار جزءًا من منظومة الفكر الحركي في تفسير الإسلام تفسيرًا سياسيًّا ونفعيًّا، فيجب إبطاله، والتحذير منه.
4- وقال شكيب في هذا الفصل أيضًا 562: «ولماذا هذه المساعي الحثيثة في تنصير العلويين سكان جبال اللاذقية، وفي فصلهم عن الوحدة السورية، والحال أن العلويين هم فرقة من الفرق الإسلامية كما لا يخفى؟!».
قال أبو مَسْلَمةَ: أدخل شكيب أرسلان ـ بدافع القومية الإسلامية! ومواجهة مخططات الأعداء! ـ العلويين (وهم النصيرية) في دائرة الإسلام فعدَّهم فرقةً من الفرق الإسلامية. ومن المعلوم عند أهل العلم والإيمان أنهم خارجون عنها، فليسوا من أهل الملَّة والقبلة، ولا كرامة. والعجب أن الشيخ أبا عُبيدة لم يتعقَّب شكيبًا في هذا الموضع ولو بتعليق لطيف خفيف؟!
نعم؛ هذه ثلاثة أخطاء شنيعة لشكيب أرسلان في هذه الرسالة الصغيرة التي أصلها في مئة صفحة فقط، ورغم أن ناشر الكتاب فضيلة الشيخ أبي عُبيدة قد أطال جدًّا في التقديم والتعليق حتى خرج في مجلدٍ ضخمٍ؛ فإنه لم ينبِّه على ما في هذه المواضع من مخالفة للحق والهدى. فكيف لو نشر الشيخ سائر مقالات شكيب وكتبه، وهي مظنَّة أخطاء في مسائل الاعتقاد والشريعة.
وإليكم بعض الأمثلة من تأصيلاته الفاسدة المخالفة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:
1- قال شكيب أرسلان في حاشية له على مقدمة كتاب «حاضر العالم الإسلامي» 1/ 9 ـ عند كلام للمؤلف في مدح المعتزلة وذم أهل الحديث ـ:
«لا شكَّ في أن الكثيرين من علماء السنة غالوا في التقليد والمحافظة على النقل، ولكن مما لا شبهة فيه أن مرجع الإيمان عند الجميع هو العقل، وهو مشرق الدين، ومناط اليقين، وبدونه لا يقوم إسلام، ولا يعتد بإيمان. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يناشد بالعقل، ويحاكم إلى العقل، ويهيب بالخلق إلى التأمل والنظر. وقد رأينا كثيرين من الأئمة مثل حجة الإسلام الغزالي وغيره ممن ليسوا بمعتزلة يقولون: إذا تعارض العقل والنقل أُوِّل النقلُ حتى يطابق العقلَ»!
2- وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور 1/ 51: «بل قد رأينا أن العلماء قالوا في الحديث: إنه علم انطبخ، حتى احترق. وأنه لم يشتغل طلبة العلم في الإسلام بشيء أكثر من اشتغالهم بالحديث، وأن التحريِّ واستيفاء شروط الثقة قد بلغا فيه الدرجة التي ليس وراءها مطمع لمزيد، ولا يزال مع ذلك الشَّكُّ يحوم حول أحاديث كثيرة واردة في الصِّحاح. وهذا الشك ليس من جهة عدم الأمانة في النقل، وقد احتاط لها أصحاب هذه الكتب ـ لا سيما البخاري ومسلم ـ بما ينفي كل شبهة، وإنما من جهة عدم استطاعة البشر ـ إلا ما ندر ـ من رواية كل ما يسمعونه بحرفه، أو من وصف كل حادثة كانوا فيها كما وقعت بلا زيادة ولا نقصان. وقد يكون اثنان في حادثة من الحوادث ويرويها كل واحد منهما بشكل يختلف قليلًا أو كثيرًا عن الآخر».
قال أبو مَسْلَمةَ: هذا تشكيك في ميراث النبوة جملةً، يردده في هذه الأيام كثير من أعداء السنة، والله المستعان.
3- وقال عن الصحابيِّ الجليل أبي ذرٍّ الغفاريِّ رضي الله عنه 1/ 191: «وكان على منزع اشتراكي يميل الى الفقراء والمساكين، ويكره ادخار الأموال».
هذا المثال يظهر كيف أن شكيبًا ينتمي إلى المنظومة الفكرية لابن صفدر الإيراني التي كانت أساسًا فكريًّا لضلالات وانحرافات الفكر الحركي الذي تبنى كثيرٌ من منظريه الاشتراكية، فألف مصطفى السباعي كتاب «اشتراكية الإسلام»، وألف سيد قطب «العدالة الاجتماعية»، في آخرين منهم.
4- وفي إطار المثال السابق الذي يظهر الأثر السيء لفكر شكيب أرسلان في الفكر الحركي؛ يجب أن نعلم أنه كان من دعاة «التقريب بين السنة والشيعة»؛ الأمر الذي تبناه كثير من الدعاة الحركيين كحسن البنا وتلاميذه وأتباعه، وندم عليه بعد ذلك بعضهم، منهم: الدكتور يوسف القرضاوي في آخر حياته.
لقد أسس شكيب في «حاضر العالم الإسلامي» 1 /192-193 لمنهج واضح في التقريب بلغ به إلى الخلط في العبادات، فقال ـ بعد كلام طويل في تزكية الرافضة وتصحيح إسلامهم ـ: «وقد صلى أعضاء المؤتمر الممثلون لجميع العالم الإسلامي مرتين بإمامة المجتهد الكبير السيد حسين آل كاشف الغطاء، ولم يخطر ببال أحد الاعتراض على ذلك بل ابتهج به المسلمون جميعًا، وصرح رياض بك الصلح ـ مفخر شبان سوريا ـ بأنه اليوم قد انبثق فجر الوحدة الإسلامية».
5- ولشكيب أرسلان كلام كثير في تعظيم محمد عبده، منه في «حاضر العالم الإسلامي» 1/ 283 تصحيحه لفهم محمد عبده للعقيدة الإسلامية بأنه: «الشكل الوحيد الذي يرجى أن ينهض بالإسلام بعد أن آل إلى هذه الحال»، وادعاؤه أنه: «اتفق الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذين قلما جاد بهم الدهر، وواسطة عقد المصلحين المجددين في هذا العصر»!
6- وقد ذكر شكيب «الوهابية» وأثنى عليها بأنها: «حركة إنابة إلى العقيدة الحق وهدي السلف الصالح واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونبذ الخرافات والبدع، وحظر الاستغاثة بغير الله، ومنع التمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الأولياء، ولذلك يسمونها عقيدة السلف ويلقب الوهابيون أنفسهم: سلفيين»، ومع هذا فقد طعنها شكيب بتهمة التعصب والغلو فقال: «والقائمون بها أولو تعصب شديد، وربما أفرطوا في مبادئهم وغلو في عقائدهم».
قلت: وسبب هذا واضح؛ فشكيب لا يوالي ولا يعادي على العقيدة الصحيحة ـ وإن كان يقرُّ بها ـ، لهذا يدخل النصيرية في دائرة الإسلام، ولا يتبرأ من دين الدرزية! حتَّى إنه لم يرتض طعن شيخه ابن صفدر الإيراني (السيد جمال الدين الأفغاني) في «تعاليم البابيَّة»، وتعقَّبه بقوله: «فأما إذا تلقاها الإنسان على شكل وصايا وعزائم، كما هو الشأن في الطرق الصوفية المتعددة، فإنه يجد فيها كثيرًا من الآداب السامية، والمبادئ المعقولة» (حاضر العالم الإسلامي: 4/ 354). ومن المعلوم أن «البابية» فرقة باطنية ملحدة، خارجة عن دائرة الإسلام.
ولا عجب بعد هذا في أن يفضل شكيب «السنوسية» على «الوهابية»:
«الدعوة الوهابية: إصلاح ديني وإنابة الى عقيدة السلف الصالح لولا ما أصابها من الغلو والافراط. أما السنوسية فهي طريقة عمل بالسنة والشريعة بدون شَطَطٍ [تحرف في المطبوع إلى: شرط] ولا قصور» (حاضر العالم الإسلامي: 1 /192 و2/ 140).
ثم ذكر شكيب 2/ 141-142 أن محمد بن علي السنوسي (ت: 1276 / 1859) توفي في زاوية جغبوب، وقال:
«وله فيها ضريح يزوره السنوسية من جميع الديار»!
ومن المعلوم أنَّ السنوسيَّ ـ هذا ـ كان إمامًا من أئمة القبورية والطرقية، وداعية من دعاة الشرك والوثنية، وقرر في كتابه «السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين» (طبعه حفيده في ليبيا: 1388 / 1968) الشرك الصراح بالاعتقاد بأرواح المشايخ والتوجه إليها والاستغاثة بها وطلب العون والمدد منها (ص: 102-105)، ورغم هذا فإن مزوِّر التاريخ الإسلامي الكذَّاب الخائن الدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي جعل في كتابه «الثمار الزكية للحركة السنوسية» ابنَ السنوسيِّ من علماء التوحيد والسنة والإصلاح!
7- ولشكيب أرسلان ثناء كبير على داعية وحدة الوجود: الأمير عبد القادر الجزائري، وقال: «وله في التصوف كتاب سماه «المواقف» فهو في هذا المشرب من الأفراد الأفذاذ وربما لا يوجد نظيره في المتأخرين، وله كتاب آخر ممتع اسمه: «ذكرى الغافل وتنبيه الجاهل» في الحكمة والشريعة» (حاضر العالم الإسلامي: 2/ 173).
قال أبو مسلمة: الكتابان (المواقف وذكرى الغافل) كلاهما في تقرير عقيدة وحدة الوجود ووحدة الأديان الإلحادية.
خاتمة:
لم أتناول في هذا المقال مضمون كتاب «لماذا تأخر المسلمون» وفكرته المركزية، وهذا أهمُّ من الأخطاء التفصيلية، لكن للكتابة فيه مجال آخر إن شاء الله تعالى، لكني أكتفي هنا بالإشارة إلى أن شكيب أرسلان لم يتناول بحثه في هذا السؤال والجواب عليه بنظرة شرعية صحيحة في ضوء العلم المفصَّل بالسنن الإلهية الكونية القدرية، والسنن الشرعية الدينية، والخصوصية الدينية والرسالية للأمة المسلمة، بل كان محكومًا بمقارنة تأخر المسلمين بتقدم الغربيين، فحصر الأمر في العمل والجدِّ والنشاط والبذل والعطاء، وقال في خاتمته:
«خلاصة الجواب: أن المسلمين ينهضون بمثل ما نهض غيرهم. إن الواجب على المسلمين ـ لينهضوا ويتقدموا ويتعرجوا في مصاعد المجد، ويترقوا كما ترقى غيرهم من الأمم ـ هو الجهاد بالمال والنفس الذي أمر به الله في قرآنه مرارًا عديدة، وهو ما يسمونه اليوم (بالتضحية)... فالمسلمون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم، وعملوا بما حرضهم عليه كتابهم أن يبلغوا مبالغ الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين من العلم والارتقاء، وأن يبقوا على إسلامهم كما بقي أولئك على أديانهم، بل هم أولى بذلك وأحرى، فإن أولئك رجال ونحن رجال، وإنما الذي يعوزنا الأعمال،...».
وله كلمة أخرى في طريق نهوض المسلمين تجدها في كتاب «مراسلات أمير البيان إلى كبار رجال العصر» (الدار التقدمية، بيروت: 2011، 257-260)؛ ليس فيها إلا الاقتداء بنُظُم العالم الغربي في التطور المادي، دون الالتفات لما أشرت إليه من السنن الكونية والشرعية.
أخيرًا: أنصح إخواني من أهل العلم وطلابه أن لا يضيِّعوا أوقاتهم وأعمارهم في الكتابات الفكرية والثقافية، وأن يُقبلوا بكليَّتهم على خدمة العلوم الشرعية ونشرها، وأجلها وأعلاها: تحقيق العبودية لله تعالى والتحذير من الشرك وإبطال شبهات أهله، وبيان العقيدة السلفية والدفاع عنها، وخدمة الأصلين: القرآن والسنة. هذا هو مراد الله تعالى من حملة العلم ابتداءً، وهو المقصود أصالةً، وما عداه فمطلوب من باب الوسائل الخادمة، ومقصود بدرجة ثانوية. والله المسؤول أن يستعملنا في خدمة دينه، والدعوة إلى سبيله، لا حول ولا قوَّة إلا به.
كتبه:
أبو مَسْلَمَةَ عبد الحقِّ بن ملا حقي التركماني
ليستر في ليلة الجمعة 4 ذو القعدة 1446، الموافق: 2 أيَّار 2025
-

ابوفهد
1 تشرين الأول 2025مقال رائع ومفيد وفقكم الله وسدّدكم وثبتكم على الحق
-

أجمل منظور
22 أيار 2025مقال رفيع جزاكم الله خير الجزاء وبارك في جهودكم