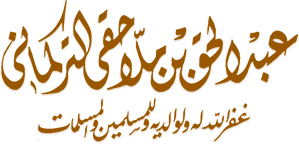اختصار الصحائف في نقد كتاب: «اللطائف والمعارف فيما لأيا صوفيا من الوظائف»
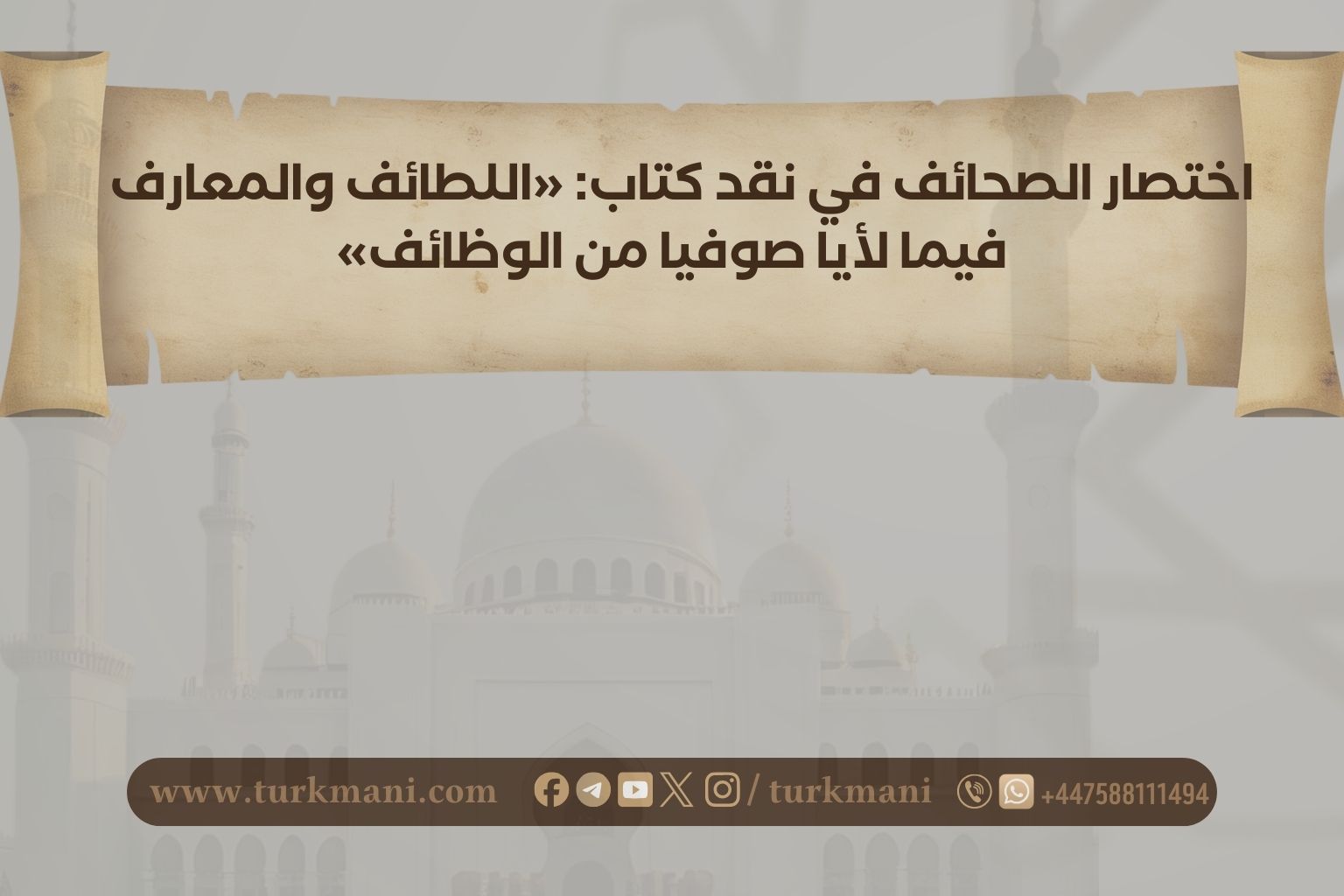
اختصار الصحائف في نقد كتاب:
«اللطائف والمعارف فيما لأيا صوفيا من الوظائف»
قال أبو مسلمة عبد الحق بن ملا حقِّي التركماني عفا الله عنه: قد تكرَّر سؤال طلاب العلم عن كتاب: «اللطائف والمعارف فيما لأيا صوفيا من الوظائف»، ولمَّا كنتُ قد اطَّلعت على هذا الكتاب عند صدوره، وكتبتْ فيه رسالةً ضمَّنْتها ملاحظاتي النَّقدية، وأرسلتها إلى مؤلِّفه الفاضل في حينه ـ قبل سنتين ـ؛ فقد رأيتُ الآن أن أعمِّم الفائدةَ بنشر تلك الرسالة، لأنَّها علميَّةٌ عامَّةٌ، وليست شخصيَّةً خاصَّةً.
ثم لا بدَّ أن أحيل القرَّاءَ ـ أيضًا ـ إلى بحثي المنشور: «الدكتور علي الصلابي وقانون قتل الإخوة والخوض في التاريخ العثماني بالباطل» (31 أيار 2023) ففيه زيادات مهمَّة غير مذكورة في هذه الرسالة، وبالله تعالى التوفيق.
ليستر في يوم الأربعاء 7 المحرَّم 1447، الموافق: 2 تموز 2025.
* * * * *
من عبد الحق بن ملا حقي التركماني إلى أخيه في الله فضيلة الشيخ البحَّاثة الموقَّر مشهور بن حسن آل سلمان ـ حفظه الله ورعاه، ووفَّقه لنصرة التوحيد والسنة ـ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله سبحانه أن تكونوا بخير وعافية في دينكم ودنياكم، وأفيدكم أنني وقفتُ على كتابكم الموسوم: «اللطائف والمعارف فيما لأيا صوفيا من الوظائف» (الطبعة الأولى في مجلدين: 1444 / 2022)، وبغضِّ النظر عن سبب تأليف الكتاب وغرضه؛ فقد استوقفتني أثناء مطالعتي للكتاب عدَّة مواضع وقع فيها أخطاء جليَّة، وأوهام ظاهرة، فأحببتُ تقييدها إفادةً لشخصكم الكريم، فالعلم رحمٌ بين أهله، والنقد والاستدراك والتصحيح من سُبُل التقرب إلى الله تعالى بخدمة العلم وأهله، كما أن تحقيق وقائع التاريخ أمانة في أعناق الباحثين، وتترتب عليه نتائج دينية ودعوية ومنهجية، لهذا أرجو أن تتقبلوا هذه الملاحظات بقبول حسن، وصدر رحب، بما يكون سببًا لإعادة النظر في الكتاب بالتصحيح والتقويم، نصيحة لله ولدينه ولعباده المؤمنين، والله المسؤول أن يزيدكم الله علمًا وخيرًا وفضلًا.
وقد بدا لي أنكم لم تتفرغوا للتأمل في مادة الكتاب ومراجعتها وتصحيحها وقتًا كافيًا، فهذه الأوهام وقفتُ عليها أثناء مطالعتي الأولى للكتاب من غير بحث ولا تتبع، لهذا أحببتُ أن أقيِّدها لكم هنا باختصارٍ، وأحيل إلى كتابكم المذكور برمز: (ل:) وأمامه رقم الجزء والصفحة، وبالله تعالى التوفيق.
1- ذكرتم ـ وفقكم الله وسددكم ـ المكتبة الخاصة للسلطان محمد الفاتح وأنه: «عيَّن المولى لطفي أمينًا لها بعض مدَّة، وكان رحمه الله يُعنى بالعلم والتعليم» (ل: 1 / 225). وترحَّمتُم عليه في المتن، وترجمتم في الحاشية للمولى لطف الله التوقاني ـ كذا في كتابكم بالنون، وصوابه بالتاء أو الدال ـ، وذكرتم أنه: «ولكثرة فضائله حسده أقرانه، ولإطالة لسانه اتهموه بالإلحاد والزندقة، فأعدم سنة 900 بفتوى ابن الخطيب».
أقول: كان لطف الله ـ الذي اشتهر بملا لطفي ـ من خواص محمد الفاتح، وبينهما صداقة أكيدة بلغت إلى حدِّ رفع الكلفة بينه وبين السلطان فكان يمازحه وينبسط إليه، وكان موغلًا في الفلسفة والمنطق والكلام. والحكم عليه بالزندقة والإلحاد جرى ـ بعد موت الفاتح ـ بأمر السلطان بايزيد الثاني، وكان قاضي المحكمة الشرعية الفقيه خطيب زاده محيي الدين أفندي (ت: 901)، ومساعده الفقيه محيي الدين أفندي المعروف بأفضال زاده (ت: 908) ـ الذي تولَّى منصب شيخ الإسلام ـ. وجاء في ترجمة ملا لطفي في «الموسوعة الإسلامية التركية»: «تم تشكيل لجنة قضائية من العلماء البارزين في ذلك الوقت، مثل خطيب زاده محيي الدين أفندي، وملا عذاري، وملا عرب (علاء الدين عربي أفندي)، وأفضال زاده حميد الدين أفندي، وملا أخوين، للتعامل مع القضية. وحُكم على الملا لطفي بالإعدام بعد جلستين استُمع فيهما لنحو مئتي شاهدٍ».
إذن؛ قُتل الرجل [بحكم القضاء الشرعيِّ]، وبفتوى علماء عصره، وبشهادة عشرات الشهود على إلحاده واستخفافه بأحكام الديانة وتلفظه بما يوجب ردَّته؛ كإنكار النبوة وسبِّ الدين.
وقد اشتهر عن أهل الإلحاد والزندقة في التاريخ العثماني ـ وغيره ـ أنه كلَّما قُطع رأس أحد منهم بسيف الشريعة؛ ادَّعوا المظلومية، وأنهم ضحايا الحقد والحسد!
2- أوردتم هذا العنوان: «تنازل الخليفة العباسي إلى سليم العثماني وكان ذلك في مبنى مسجد أيا صوفيا» (ل: 1 / 231). ثم أوردتم تحته خبر التنازل، وقلتم: «وجرت مراسم هذا الحفل التاريخي في أيا صوفيا». ثم دللتم على ذلك بقولكم: «جاء في «الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» 1 / 34-35 ـ بعد كلامٍ ـ: «ومن ناحية أخرى: فإن سقوط الحكم المملوكي قد جاء معه بإمكانية جديدة بالنسبة للسلطنة العثمانية؛ وهي مسألة الخلافة التي طالما دار الجدل حولها، فالمعروف أن الرواية القائلة بأن السلطان سليم الأول صحب الخليفة المتوكل إلى إستانبول، فتنازل له الأخير عن الخلافة في احتفال أقيم في جامع أيا صوفيا؛ قد ظهرت في القرن الثامن عشر، وأن هذه الرواية لم تذكرها المصادر المعاصرة، ولم تشر بأية معلومات عن ذلك الموضوع، غير أن عدم وقوع حادثة كهذه؛ لا يعني أن السلاطين العثمانيين الذين خلفوا السلطان سليم الأول لم يقبلوا الخلافة،...» إلى آخر النقل الطويل حتى آخر الصفحة 232.
أقول: كتاب «الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» كتاب دعائيٌّ، لكنه ـ أيضًا ـ كتاب أكاديميٌّ محكَّم، لهذا فإن المثالب والمساوئ إما أنها لا تذكر فيه أصلًا، حتى لا يضطرَّ المؤلفون (الأكاديميون) إلى تزوير التاريخ، أو تذكر بلغة (دبلوماسية)، كما فعلوا في هذا الموضع، فإنَّ خبر تنازل الخليفة العباسي للسلطان العثماني في مسجد أيا صوفيا لا أصل له، والوصف الصحيح الصريح له بأنه: كذب واختلاق وقول باطل، وهو ما عبَّر عنه مؤلفو الكتاب بقولهم اللطيف:
«1- قد ظهرت في القرن الثامن عشر.
2- وأن هذه الرواية لم تذكرها المصادر المعاصرة.
3- ولم تشر بأية معلومات عن ذلك الموضوع».
ثم جزموا بالنتيجة: «غير أن عدم وقوع حادثة كهذه».
فكلامهم صريح في تكذيب هذا الخبر، فاستنتاج فضيلتكم ـ سدَّدكم الله ـ من كلامهم ما جزمتم به في العنوان ثم قولكم: «وكان ذلك في مبنى مسجد أيا صوفيا»؛ وهْمٌ بعيدٌ، وخطأ لا وجه له.
والحقُّ في أصل هذه المسألة ما قال المؤرخ التركي الكبير خليل إنالجيك ـ وسأذكر بعدُ مكانته العلمية ـ في كتابه: «تاريخ الدولة العثمانية» 92: «ليس من الصحيح أن الخليفة العباسي المتوكل قد تخلَّى للسلطان سليم عن الخلافة».
3- ذكرتم سعيدًا النورسيَّ، وقلتم في الحاشية (ل: 1 / 447): «(النورسي) نسبة إلى (النور)، ويكثر من استخدام كلمة (النور) في رسائله وكتبه، لذا؛ جماعته ـ الآن ـ في تركيا يسمون أنفسهم بـ(جماعة النورجي)، ولا يقصدون بـ(النور) ـ غالبًا ـ إلا التجليات الربانية التي تحصل لهم أثناء الذكر الجماعي على طريقة صوفية».
أقول: لم تذكروا مصدر هذا الكلام، وهو خطأٌ، مخالف لجميع المصادر التي ذكرت ترجمة النورسي، فقد اتفقت على أن هذه النسبة إلى مسقط رأسه، وهو: «قرية نُورْس، التابعة لناحية اسباريت، المرتبطة بقضاء خيزان، من أعمال ولاية بتليس» كما في «كليات رسائل النور: سيرة ذاتية» ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار النيل، القاهرة: 1434، 51.
وفيه أيضًا 58: قال سعيد النورسي: «أما قريتنا نورس».
وقال: «إن أولئك النورسيين يتباهون لأن قريتهم نورس ستكتب فخرًا عظيمًا بنور رسائل النور».
وقال ـ أيضًا ـ 261: «إن سبب إطلاق رسائل النور على مجموع الكلمات هو أن كلمة النور قد جابهتني في كل مكان في حياتي، منها: أن قريتي اسمها: نورس. واسم والدتي المرحومة: نورية...».
4- نقلتم كلام شكيب أرسلان وفيه ذكر العهدة العمرية عند فتح بيت المقدس (ل: 1 / 469)، وعلَّقتم عليه بنصِّ العهدة من «تاريخ الطبري»، ثم قلتم: «وخرجتها في كتابي «البخائس والنفائس من خمس طرق عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه». وكررتم هذه الإحالة في الصفحة التالية، وقلتم: «وذكرت (الشروط العمرية) مع تخريجها...».
أقول: في هذا خلط بين العهدة العمرية والشروط العمرية، أما «العهدة» فكانت عند فتح بيت المقدس، وقد سافر إليها عمر الفاروق رضي الله عنه بنفسه، وهي صحيحة ثابتة لا خلاف فيها.
وأما «الشروط» فهي التي ذكرتم تخريجها في كتابكم الآخر، وفي ثبوتها خلاف طويل، وشكٌّ كبيرٌ، ليس هذا موضع بحثه. وقد رأيت في كتابكم الآخر تنبيهكم إلى التفريق بين الوثيقتين، فيكون ما ذكرتموه هنا سهوًا عارضًا.
5- جرى ذكر معلِّم السلطان محمد الفاتح: الشيخ آق شمس الدين، فأطلتم في ترجمته (ل: 1 / 591-593) بما يُفهم منه تحسين حاله، وختمتم الترجمة بقولكم: «رحمه الله تعالى، وأدخله فسيح جناته».
أقول: آق شمس الدين من دجاجلة التصوف، وبه وبأمثاله انتشرت العقائد الفاسدة، والطرقية القبورية في الأناضول، وقد استغلَّ منزلته ووجاهته عند السلطان لبثِّ ضلالاته الصوفية، خاصة عند فتح القسطنطينية (857 / 1453)، حيث حدَّد موضع قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قائلًا: «إنِّي أُشاهد في هذا الموضع نورًا، لعلَّ قبره هاهنا!» وذهب لذلك الموضع وتوجَّه زمانًا، ثم قال: «التقَتْ روحُه مع روحي! وهنَّأني بهذا الفتح! وقال: شكر الله سعيكم حتى خلصتموني من ظلمة الكفر» (الشقائق النعمانية: 140).
وقد انخدع السلطان بدعواه، وأمر ببناء القبة على ذلك الموضع، فكان ذلك أول خطوة في التأسيس للقبورية في القسطنطينية بعد أن فتحها الله تعالى على يد أهل الإسلام، وطهَّرها من أوثان النَّصارى وصلبانهم.
المؤلفات القليلة التي تركها آق شمس الدين تدلُّ على انغماسه في بدع التصوف، وغلوه فيها، فقد ألَّف رسالة في الدفاع عن ابن عربي، وهي «الرسالة النورية»، ولها نسخ خطية كثيرة، وقرَّر فيها ما سمَّاه بـ: «التوحيد الذاتي التلاشي الذوباني الاضمحلالي المحوي» (شهيد علي باشا: (2720)، ورقة: 90/ب). وقد ذكر هذا عن شيوخ الصوفية، وأطلق عليهم عبارات التبجيل والثناء، وفيهم كثير من الغلاة الملاحدة كابن الفارض والجلال الرومي وصدر الدين القونوي، وغيرهم.
وكان آق شمس الدين عندما انتقل إلى أرض الروم من بلده: دمشق؛ لازم في أنقرة الشيخ الحاج بيرام (ت: 833 / 1429)، واشتغل عليه بالتحصيل، وأخذ عنه طريقته الصوفية التي كانت: «تنتهج الفكر الصفويَّ في مسلكها الصوفيِّ» كما في «الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» 2 / 183.
ويكفينا في معرفة حال آق شمس الدين شهادة العلامة الفقيه ملا علي القاري الحنفي (1014 / 1606) في كتابه «الرد على القائلين بوحدة الوجود» (دار المأمون، دمشق: 1415) فقد ذكر انتصارَ الآق شمس الدين لابن عربي في رسالته هذه، ثم قال ملا علي القاري في تجريحه وذمِّه 127-128:
«فعلى كلِّ حالٍ: هو من الطائفة الإلحادية، لمخالفته لما هو مقرر في العقائد الشرعية، التي بيَّنها العلماء الإسلامية. وقد أغرب حيث استدلَّ على صحة كلام ابن عربي بكلام أتباعه، كشُرَّاح كلامه، ووُضَّاع مرامه، ثم خلط وخبط بإيراد كلام الوجودية الموحِّدة، والوجودية المُلْحِدة في الشاهد على طبق الواحد».
[وهو في «مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري»، رسالة «مرتبة الوجود ومنزلة الشهود»، دار اللباب، اسطنبول: 1437، 6 / 222].
6- ذكرتُم ـ رعاكم الله ـ حادثةَ قتل السلطان محمد الفاتح لأخيه الرضيع، وتشريعه لقانون قتل الإخوة في مبحثين (ل: 2 / 288-299)، وأوردتم نقلًا مطولًا من كلام نامق كمال من 294 إلى آخر المبحث: 299. وصرحتم بتكذيب واقعة قتل أخيه 2 / 290: «فليس قتل محمد الفاتح أخاه أحمد إلا افتراء عليه». وكذلك 2 / 288 أنكرتم إصداره قانون قتل الإخوة.
أقول: هاهنا مسألتان:
أما أمر السلطان محمد الفاتح بقتل أخيه الرضيع خنقًا؛ فالبحث التاريخي يثبت صدق روايته، وصحة وقوعه، لهذا لم يتردَّد المنصفون من محبِّي الفاتح ومعظِّميه في الإقرار بصحة الواقعة، وقد ذكرتم في كتابكم هذا (ل: 1 / 244): «الأستاذ أحمد خيري باشا (ت: 1343 هـ / 1924م)» وسقتم له: «قصيدة غراء أشاد فيها بذكرى فتح إستانبول وفاتحها السلطان محمد الثاني». وفيها هذا البيت (ل: 1 / 250):
«دع عنك بعض هناته لفتوحه ولعلَّ فيها ما يسوغُ ويُشرعُ»
ونقلتم في الهامش تعليق صاحب القصيدة نفسه على هذا الموضع، حيث قال: «والمراد ما حدث من السلطان من قتل أخيه الرضيع...» ثم أورد ـ هو ـ كلامًا متكلَّفًا في الاعتذار له. فتعقَّبتموه بقولكم: «هي من الخرافات والبواطيل والترهات التي نسبت لمحمد الفاتح وهو بريء منها».
قلتُ: أحمد خيري باشا معروف بحبِّه للأتراك، وقد قال في قصيدته هذه:
«لا تعجبوا من صرحتي وإشادتي بالترك أو أني بذلك مولَعُ»
«فلهم لديَّ صنيعة وخؤولة وأخوَّة في الدين لا تتزعزع»
وكان أحمد خيري من تلاميذ الشيخ العثماني محمد زاهد الكوثري، فلو كان في صحة هذه الواقعة أدنى مدخل للشكِّ؛ لكذَّب بها هذا المعظِّمُ للفاتح.
والمذكور في تاريخ وفاته غلطٌ، صوابه: (1387هـ / 1967م).
وذكرتم في كتابكم ـ أيضًا ـ (ل: 1 / 600): «محمد فريد بك المحامي (ت: 1338) في كتابه: تاريخ الدولة العليَّة العثمانية». ونقلتم ترجمة الفاتح من هذا المصدر القيِّم، وفيها قول محمد فريد: «وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصة لدفنها بها؛ أمر بقتل أخ له رضيع اسمه: أحمد». فعلَّقتم عليه بقولكم: «فيه ما ترى، وهذا غير صحيح، نسجه أعداء العثمانيين، ممن غاظهم محمد الفاتح وبطولاته ومناقبه، وسيأتي بيان أنه من الخرافات في اللطيفة الثلاثين».
أقول: ما نقلتموه في «اللطيفة الثلاثين» من بعض الكتب الدعائية كلام عاطفي لا مستند له، خاصة الكلام الطويل لنامق كمال 2 / 294-298؛ فإنَّه كان شاعرًا وأديبًا، ذو نزعة صوفية وفكرية، وكتب كتابه هذا في «سيرة الفاتح» لتمجيد الأبطال، ولم يلتزم بأصول البحث التاريخي، لأنه لم يكن مؤرخًا، لهذا جاء في ترجمته في «الموسوعة الإسلامية التركية» ما ترجمته:
«على الرغم من أن نامق كمال أراد الوصول إلى الأعمال والمخطوطات الأصلية أثناء كتابة التاريخ العثماني؛ فإنه اضطر إلى الاعتماد في الغالب على المصادر العادية (غير ذات قيمة)؛ إذ لم يكن في الإمكان في رودوس وساكيز [حيث كان يقيم في اليونان]؛ أكثر من هذا. إنه استند أثناء حكمه على الحوادث ـ حقيقةً ـ إلى المنطق بدلًا من الاستناد إلى الوثائق، وهذا عيبٌ كبيرٌ في كتابته يجعلها بعيدةً عن كونها كتابةً علميَّةً».
أما الشاعر أحمد خيري فلا يخفى عليكم معرفته بالتاريخ العثماني وإعجابه بالفاتح، وأما محمد فريد بك فهو تركيُّ الأصل، ولد ونشأ في القاهرة، وكان عارفًا باللغة التركية وآدابها ومصادر تاريخ الدولة العثمانية، وألَّف كتابه قبيل سقوط الدولة العثمانية، وكان دافعه المحبة والإعجاب والتعظيم، وقد ذكر في مواضع وقائع تنفيذ «قانون قتل الإخوة» ونبَّه على تأثيره في إضعاف حكم آل عثمان.
ومن أشهر المعاصرين الذين أثبتوا صحة واقعة قتل الفاتح لأخيه الرضيع، وعدَّ صنيعه من مفاخره في السياسة حفاظًا على السلطنة؛ المؤرخ التركي قادر مصر أوغلو (ولد في طرابزون: 1933، وتوفي في اسطنبول: 2019)، وكان مدافعًا عن الدولة العثمانية وتاريخها، وله في ذلك مؤلفات ومقالات ومحاضرات كثيرة، وسُجن ونفي بسبب ذلك. وعند وفاته نعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله: «علمت بحزن وفاة قادر مصر أوغلو أحد مؤرخي بلادنا المهمِّين».
وإذا تجاوزنا هذه الآراء المتأخرة، ورجعنا إلى المصادر الأصلية للتاريخ العثماني فإنَّ النتيجة النهائية هي أنَّ: «جميع مصادر التاريخ العثماني المعتبرة سجَّلت أمر السلطان الفاتح محمد الثاني بخنق أخيه الرضيع أحمد. أعني لا يوجد في هذا الموضوع أي اختلاف بين المؤرخين. ومن يقول عكس هذا، أو يكذِّب الروايات ليس لهم أي مرجع. في بعض التواريخ العثمانية ذكرت الحادثة مجرَّدةً، وفي بعضها ذكرت مع توضيحها. وذكرت بعض المصادر الحادثة للمبالغة في التشنيع على السلطان الفاتح»؛ كما قال محمد أَقْمان في أطروحته للدكتوراه: «مسألة قتل الإخوة في القانون العثماني»، التي أجيزت من جامعة مرمرة، معهد العلوم الاجتماعية، فرع علم تاريخ القوانين، اسطنبول: 1995، 62.
والمسألة الثانية هي «قانون قتل الإخوة»: وهو فقرة من «قانون نامه» الذي أصدره محمد الفاتح، ونصُّها: «وكلُّ من تيسَّرت له السَّلْطنةُ من أولادي؛ فمن المناسب أن يُقتَل جميعُ إخوته من أجل نظام العالم. جوَّزه أكثر العلماء؛ فيكون نافذًا من الآن».
لقد كان لدى بعض الباحثين بعض الشكِّ في صحَّة هذه الفقرة، لأنها لم ترد إلا في مخطوطة وحيدة، محفوظة في المكتبة الملكية في فيينا، لكن زال الشكُّ كلُّه بعد ظهور كتاب: «بدائع الوقائع» بالتركية العثمانية، لمؤلفه: المؤرخ حسين البوسنوي (ت بعد: 1056 / 1646) ـ وكان من رجالات السلطان مراد الرابع، وولي منصب رئيس الكُتَّاب ـ، وقد نُشر في موسكو عام (1961م)، وكان أول من لفت الأنظار إلى حفظ هذا الكتاب لنص القانون الباحث التركي عبد القادر أوزجان في بحثه الموسوم: «قوانين الفاتح التنظيمية ومسألة قتل الإخوة من أجل نظام العالم»، الذي نشره أولًا في مجلة التاريخ لكلية الآداب، جامعة اسطنبول، سنة: (1982م)، عدد: (33)، ثم عاد إلى نشره مع نصِّ القانون كاملًا، في كتاب صغير بعنوان: «قانون أسلافي وأجدادي: قانون نامه آل عثمان»، صدر في اسطنبول، الطبعة الأولى: (2017م)، والثانية: (2018م).
لقد اعتُمِد بحثُ أوزجان في الأوساط الأكاديمية، وهي من مصادر مواد «الموسوعة الإسلامية التركية» في نحو عشرين موضعًا. بل إن هذه «الموسوعة» استكتبت أوزجان لكتابة مادة (جلوس CÜLÛS) فكتبها أوزجان، وأورد فيها نصَّ «قانون قتل الإخوة» جازمًا بصحتها، ولم يورد أي اعتراض أو شكٍّ حولها، بل قال:
«جعل الفاتح من خلال وضعه لهذا الحكم جميعَ أبنائه ورثةً للعرش بالتساوي، ورأى أنه من المناسب أن يقتل من يجلس على العرش بقيةَ إخوانه: «من أجل نظام العالم». في واقع الأمر أثبت القتالُ على العرش ـ بعد وفاته ـ بين ولديه بايزيد وجَمْ سلطان أنه كان على حقٍّ».
وقال أوزجان في هذه المادة ـ أيضًا ـ: «في الدول التركية قبل الإسلام تسببت حقيقة أن أعضاء السلالة كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في العرش في بعض الأحيان في صراعات على العرش أضعفت الدولةَ، ثم نُقلت نفس الطريقة إلى الدول التركية المسلمة». يعني أن هذا سبب قتل من يتولى العرش لإخوانه، إذ كان يخشى تمردهم ولو مستقبلًا، لكنه ذكر أنه: «في عهد السلاجقة لم نجد أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة ـ ممن لم يحاول فعلًا التمرد ـ قد أُعدم بسبب الخوف من أنه قد يطالب بحقه في السلطنة». ثم ذكر أوزجان جملة من حوادث قتل الإخوة في الدولة العثمانية.
إنَّ «الموسوعة الإسلامية التركية» من أهم المصادر العلمية المحكَّمة في تركيا، وهي من أعظم الإنجازات العلمية الموسوعية للمسلمين في العصر الحديث، وقد صدر عن مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، ابتدأ العمل فيها عام (1983)، واكتمل بصدور المجلد الرابع والأربعين عام (2016).
وفي أطروحة محمد أقمان ـ التي ذكرتها آنفًا ـ تأكيد على صحة ما ذهب إليه أوزجان.
وفي اللغة التركية عشرات الأبحاث والمقالات حول هذا الموضوع، ومن طريف ذلك أن باحثة من كُوريا كتبت رسالة ماجستير بعنوان: «قتل الإخوة في الدولة العثمانية وكوريا: دراسة مقارنة»، وأجيزت عن جامعة مرمرة في اسطنبول (2018).
والمقصود أن نسبة «قانون قتل الإخوة» إلى السلطان محمد الفاتح أصبحت أمرًا مسلَّمًا في الأوساط العلمية والبحثية الأكاديمية.
ولو فرضنا جدلًا عدم ثبوت نسبة نص القانون للفاتح، فإن تطبيق هذا القانون من قبل عدد من سلاطين آل عثمان يدلُّ على أن له أصلًا أصيلًا عندهم، ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وقد أورد محمد أقمان إحصاءً دقيقًا لوقائع «قتل الإخوة»، فبلغ عدد الضحايا (35) أخًا مقتولًا:
1- فقد قتل مراد الأول أخويه.
2- وقتل بايزيد الأول أخاه.
3- وقتل مراد الثاني أخاه.
4- وقتل الفاتح محمد الثاني أخاه.
5- وقتل سليم الأول أخويه.
6- وقتل مراد الثالث إخوانه الخمسة.
7- وقتل محمد الثالث إخوانه التسعة عشر في ليلة واحدة.
8- وقتل عثمان الثاني أخاه.
9- وقتل مراد الرابع إخوانه الثلاثة.
وبما أنكم نهجتم في كتابكم منهج الاستطراد والتوسع في النقولات لأدنى مناسبة؛ فقد كان من المناسب جدًّا أن تذكروا مسألة هي في غاية الارتباط بتاريخ أيا صوفيا، وهي أن من مظاهر تعظيم سلاطين آل عثمان لهذا الجامع أنهم بنوا قبورهم عنده، وبلغ عدد المدفونين في أيا صوفيا من آل عثمان نحو مئة وخمسين من رجالهم ونسائهم، بينهم خمسة سلاطين، قبر اثنين منهم في داخل أيا صوفيا، وهما: مصطفى الأول، وإبراهيم الأول، والثلاثة الباقون في محيطها.
وبين تلك المباني الضخمة الفخمة التي تضم تلك القبور المبنى الذي يضمُّ قبر السلطان مراد الثالث، وعند قدميه قبور تسعة عشر ابنًا من أبنائه، قتلوا جميعًا خنقًا في يوم واحد، يوم السبت: 17 جمادى الأولى 1003 / 28 كانون الثاني 1595، أمر بقتلهم أخوهم: السلطان محمد الثالث، الذي تولى السلطنة بعد وفاة أبيه: مراد الثالث، فأمر بحفر عشرين قبرًا عند أيا صوفيا، ودفن في يوم واحد: أباه السلطان ومعه جميع إخوانه، يقال: إن أكبرهم لم يتجاوز الحادي عشرَ من العمر. ويقال: إن أربعة منهم كانوا بالغين، والباقون لم يبلغوا الحلم، ولم يجر عليهم القلم! وصارت «أيا صوفيا» شاهدةً على جريمة وحشية، وهمجية بشعة، نُفِّذَتْ باسم: «قانون حفظ نظام العالم»!
وذكر السياسي والمؤرخ العثماني علي فؤاد تُركْ كالْدِي (ت: 1935) في «مذكراته» أن السلطان محمد رشاد (ت: 1337 / 1918) زار يومًا قبور أجداده في أيا صوفيا، فأعرض عن زيارة قبر محمد الثالث، وقال: «أنا لا أذهب لزيارة قبر رجلٍ قتل تسعة عشر أخًا له في يوم واحد»!
إن أخبار وقائع قتل الإخوة من قبل سلاطين آل عثمان مشهورة مستفيضة، بل متواترة معلومة، حتى إن العلامة الفقيه الحنبلي الشيخ مَرْعيَّ بن يوسف الكرميَّ ثم المصريَّ (ت: 1033) لما ألَّف كتابه: «قلائد العقيان في فضائل آل عثمان» لم يستطع تجاهل هذه الحقيقة التاريخية الثابتة، فقلب هذه «السيئة» إلى «فضيلة»، وتناقض في توجيه ذلك شرعًا وفطرةً وعقلًا تناقضًا كبيرًا. وقد ظهر لي أن الشيخ الكرمي اضطر إلى تأليف هذا الكتاب تحت ضغط أحد ولاة الدولة العثمانية في مصر، وسأنشر بحثي حول هذا في مناسبة أخرى. أما كتاب «قلائد العقيان» فهو منشور مشهور، وهو من مصادركم في كتابكم هذا.
ولا يمكن أن أنهي هذا المبحث دون أن أذكر أنَّ المؤرخ التركي الكبير خليل إنالجيك (ت: 2016) قد أثبت صحة نسبة «قانون قتل الإخوة» إلى محمد الفاتح، فقال في كتابه: «تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار»، ترجمة: محمد الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي، ليبيا: 2002، 96، ما نصُّه ـ بعد أن شرح العُرف التركي في انتقال السلطة وظاهرة الصراع بين الإخوة ـ:
«لقد كانت هذه الحقيقة في ذهن السلطان محمد الفاتح حين شرَّع في «قانون نامه» الذي أصدره ما كان يُمارَس منذ بداية الإمبراطورية: «يمكن لأيٍّ من أبنائي، الذي سيهبه الله السلطنة، أن يتخلص من إخوته لأجل مصلحة الدولة، وهو ما تقرُّه غالبيَّة العلماء»؛ إلا أن هذا الحلَّ لم يُنْهِ الحروب الأهلية، لأن السبب الرئيسي وراءها كان يكمن في التقاليد التركية القديمة...» إلى آخر كلام إنالجيك.
وإنالجيك هو أوثق وأدقُّ من أعاد كتابة التاريخ العثماني، ويعدُّ أحد الشخصيات العلمية المتميزة في العالم خلال القرن الأخير، ويلقَّب في تركيا بشيخ المؤرخين، وقد أجمع الإسلاميون والعلمانيون في تركيا على صدقه وأمانته، وعلمه وتحقيقه، واجتمعت كلمتهم على احترامه وتبجيله، وعند وفاته عام: (2016) شارك في تشييعه ومراسم دفنه أكبر القيادات السياسية والعلمية والثقافية في تركيا، وعلى رأسهم أحمد داود أغلو ـ رئيس الوزراء آنئذٍ ـ، وأصدر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نعيًا رسميًّا قال فيه: «قد علمتُ بحزن عميق بوفاة المؤرخ العالمي البروفيسور الدكتور خليل إنالجيك، الذي كرس حياته لدراسات التاريخ التركي والعالمي، وهو من بين المؤرخين البارزين في العالم بأعماله المحايدة والمعتمدة. ترك لنا إرثًا فريدًا من خلال كتبه ومراجعاته وتقييماته. مُعلِّمنا الموقَّر ـ الذي درَّس في جامعات مرموقة في العالم وسلَّط الضوء على التاريخ بأبحاثه ـ سيظل دائمًا في الذاكرة بالحب والاحترام للطلاب الذين دربهم. رحم الله خليل إنالجيك؛ الاسم العظيم للتاريخ التركي، ومعلِّم المعلمين». ودُفن في مقبرة الفاتح تكريمًا له، وكان حصل على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عام (2011).
ومن أسفٍ أن هذا المؤرخ الحجَّة لا يكاد يُعرف في الأوساط العربية، ولا أعرف له كتابًا مترجمًا إلى العربية إلا ثلاثة كتب له، وهي: «تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار»، و«التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية»، و«السلطنة العثمانية وأوروبا».
7- ذكرتم وصية محمد الفاتح التي كانت حول قبره ثم أزيلت، وفيها: النهي عن الطواف بقبره والاستغاثة به. وفي الحاشية (ل: 2 / 313): «قال أبو عُبيدة: جهدت أن أجد هذه الوصية في الكتب التي ترجمت لمحمد الفاتح فلم أجدها».
أقول: ما ذُكِرَ أولًا لا شكَّ أنه وهمٌ من ناقله، ولعلها كانت نسخة من اللوحة التي تضعها «رئاسة شؤون الأديان» عند القبور المعظَّمة التي يقصدها الناس بالزيارة، وفيها بيان آداب زيارة القبور، والتنبيه على أن القبور لا يسجد إليها ولا يصلَّى لها. وقد أحسنتم ـ بارك الله فيكم ـ في التنبيه على أنكم لم تجدوا لهذه الوصية أصلًا، فليتكم نزهتم كتابكم عمَّا لا أصل له.
8- حول عقيدة محمد الفاتح واستقامته وموقفه من التصوف والبدع:
جميع ما أوردتم من النقولات في هذا الخصوص (ل: 2 / 300-327) إنما هو أمورٌ عامة لا يمكن أن يثبت بها مسألة خاصة ولا أن تنفى، فالأمر بالصلاة والاستقامة والعدل واتباع السنة والنهي عن البدع المفسدة والكبائر العملية والفواحش والظلم؛ شيءٌ مشترك بين جميع فرق الأمة البريئة من الزندقة والنفاق، وإنما يحكم على المعيَّن بالاستقامة على منهاج التوحيد والسنة إذا ظهر منه ـ قولًا وعملًا ودعوةً ـ الاعتزاز بما يختصُّ به أهل التوحيد والسنة بين سائر الفرق؛ من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في العبادة، ونفي الشرك، والدعوة إلى السنة علمًا وعملًا، ومحاربة البدع الاعتقادية والعملية.
ومصطلح «أهل السنة» أو: «أهل السنة والجماعة» عند العثمانيين؛ يجب أن يُفهم في ضوء اصطلاحهم واستعمالهم، فإنهم يطلقون هذا المصطلح ويريدون به واحدًا من ثلاثة معانٍ:
الأول: أهل السنة مقابل الرافضة والشيعة والخوارج.
الثاني: أهل السنة بمعنى: الأشعرية والماتريدية، ويقابلهم المعتزلة، أما «السلفية» فلا يعرفون بمذهبهم في أصول الاعتقاد أصلًا.
الثالث: أهل السنة بمعنى الفقهاء والطرق الصوفية الرسمية، ويقابلهم: الباطنية والزنادقة والطرق الصوفية الإباحية.
ويذكرون «السلف» في سياق الاقتداء بأخلاقهم وآدابهم وزهدهم وتدينهم، كما هو اصطلاح الصوفية.
وقد جرى ذكر الكوراني (ل: 2 / 306) وهو معروف بأشعريته، فكيف يصحُّ أن يُذكر ـ ولو نقلًا ـ: «سلامة معتقده السني السلفي»! مع أنكم نبَّهتم في تعليقكم 2 / 309 على قول الكوراني بأن ما في المصحف ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وأزيد هنا بأن الكوراني وصف في كتابه: «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» 4 / 222 المثبتين لكلام الله بأنهم: «الحنابلة والحشوية». وقال فيه ـ أيضًا ـ 4 / 363: «ونعتقد أن الشيخ أبا الحسن الأشعري شيخ أهل السنة في أصول الدين على الحق، ومخالفوه على الباطل كالكرامية والحشوية». فهذا مفهوم «السنة» و«أهل السنة» عند الكوراني.
وهناك حقائق مجهولة بالنسبة لنا، لا يمكن الحكم في حقِّ الفاتح دون معرفتها على وجه التفصيل من مصادرها الأصلية، من ذلك مثلًا:
(1) أن الفاتح كان مولَعًا بالصور والتماثيل، ولم يكن في المسلمين من يتقن صنعها لما هو مقرَّر لديهم من تحريمها تحريمًا ظاهرًا معلومًا، فاستقدم الفاتح من إيطاليا الرسام الشهير جينتيلي بيليني (ت: 1507)، وأقام في قصره سنة كاملة، ورسم الفاتح في لوحة شهيرة، ما زالت محفوظة في معرض لندن الوطني. كما طلب الفاتح منه ومن فنَّانين آخرين استقدمهم ـ أيضًا ـ رسمَ لوحات وتماثيل مختلفة زيَّن بها جدران قصره. وعندما تولَّى بعده ابنه: بايزيد الثاني تخلَّص من أكثرها.
[(2) أن السلطان محمد الفاتح أمر أحد الرسامين برسم لوحة السيدة مريم مع ابنها المسيح عليهما السلام، كما ورد في مصدرين إيطاليين مستقلين.
(3) أن محاكمة ملا لطفي جرت بأمر السلطان بايزيد الثاني، لأنه كان ناقمًا على والده الفاتح، وكان يتهمه في ديانته، وكانت زندقة ملا لطفي مشتهرة، لكنه كان في حماية الفاتح وحصانته.]
(4) ومنها أيضًا: أن الفاتح كان يقيم في قصره مجالس الشرب والطرب (الموسيقى)، وهو أمر مشهور، لا خلاف في وقوعه؛ كما قال المؤرخ خليل إنالجيك في كتابه: «عيش الطَّرَب»، [وهو كتاب كبير ألفه أنالجيك لتوثيق ما كان في قصور السلاطين من مجالس الشرب والطرب وما يتصل بذلك من فساد وإنحلال.]
(5) وفي «ديوان شعر الفاتح» الذي طبعته هيئة المخطوطات والآثار التركية، بتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (2014)؛ قصائد فاضحة في التغزل بالذُّكران، منها تغَزُّله بشابٍّ كاهنٍ في غَلَطَة. وقد كُتبت في توثيق هذا وتحليله عدة دراسات، والتوسع فيه يحتاج إلى استحضار المصادر واستنطاقها.
هذه الإشارات تفيدنا بأن المعرفة الصحيحة بعقيدة الفاتح وتدينه واستقامته يحتاج إلى الاطلاع على المصادر الأصلية باللغات العثمانية والفارسية وعدد من اللغات الأوروبية على وجه التفصيل، وتمييز النقولات، والتوثق من صحتها، والحكم بميزان العدل والإنصاف، دون التأثر بالأحكام الدعائية المبثوثة ـ للأسف! ـ في الكتب المنشورة باللغة العربية.
9- اقتباسات غير موثقة:
لاحظت أثناء مطالعة الكتاب أن في ثناياه مواضع غير قليلة لم يُبَيَّن مصدر النقل فيها، ويظهر هذا بأدنى تأمل في أسلوب الكلام وسياقه، فإن أسلوبكم الخاص الذي يغلب عليه اللغة الشرعية يخالف أسلوب المؤرخين والأدباء والمترجمين:
1- من ذلك ما ورد في 1 / 226 (إنجازات محمد الفاتح وانتصاراته العظيمة)، فجميع ما تحت هذا العنوان إلى آخر المبحث من كلام علي همت بركي دون عزوٍ. وهو مصدر قد أكثرتم من النقل عنه، مع أنه مصدر دعائي متأخر، ليس له أي قيمة علمية، وكان مؤلفه قاضيًا ولم يكن مؤرخًا، توفي سنة: (1976).
2- ومنه ما ورد في 1 / 303، ابتداء من السطر: 5، إلى آخر الصفحة: 304؛ فكله منقول من كلام الصفصافي أحمد المرسي، دون عزوٍ إليه. وكتابه دعائيٌّ ـ أيضًا ـ، لا قيمة له في ميزان البحث العلمي.
3- ومن ذلك ـ أيضًا ـ التعليق رقم (1) في: 1 / 280 على ما جاء في رسالة الفاتح من إنشاء الكوراني: «سخَّرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي بالضرب الحيدري لآل عثمان». فإن الكلام الوارد في هذا التعليق هو للدكتور عبد الجليل التميمي في «دراسات في التاريخ العربي العثماني» 36، وقد غفل عن المعنى المقصود بهذه الاستعارة فاشتط ذهنه بعيدًا. ولا يخفى على فضيلتكم أن المراد حكم الصديق والفاروق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فكأنه يقول: إن حكم آل عثمان تمثل فيه نموذج هؤلاء الخلفاء الراشدين. أما إن كان الكوراني يقصد بكلامه هذا تأثيرهم بأنهم سخَّروا آل عثمان لحرب أعدائهم؛ فتلك قاصمة؛ نعوذ بالله منها.
هذا آخر الملاحظات على كتابكم «اللطائف والمعارف»، أحببت أن أضعها بين أيديكم، لثقتي بحرصكم على تحقيق العلم وتوثيقه وتحريره، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليستر يوم الخميس 28 شوال 1444، الموافق: 18 أَيَّار 2023.
قال أبو مسلمة عبد الحق التركماني: هذه آخر الرسالة التي بعثتها إلى فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان بالتاريخ المذكور، وقد صححت في هذه النسخة بعض الأخطاء الطباعية، وكذلك صححتُ خطأ وقع لي في تسمية مؤلف (بدائع الوقائع)، وبالله التوفيق.
-

ابو الحسن
14 ايلول 2025ما شاء الله
كلام رصين و منطقي
و تعلمنا شيئا من خبرة الرجل عن حال العثمانيين و تاريخهم.
حفظ الله جهد في نشر السنة بينهم -

أبو عبد المليك مراد مزيان
3 تموز 2025الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
بارك الله فيكم على هذه التعقيبات المفيدة
والتي صيغت بأدب جم ورحمة ورأفة بأخيكم الشيخ مشهور
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تطبيقكم لمنهج الرد العلمي الجامع بين رد الخطأ مع حفظ الكرامة والمنزلة للمردود عليه
وهكذا رد يفرح صاحبه ويفتح علبه باب قبول الحق وتصحيح الأخطاء
محبكم أبو عبد المليك مراد مزيان الجزائري