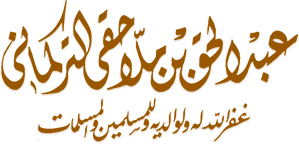تعليقة على مقال: (عُلماءُ الأشاعرة بَينَ جِنايةِ الغُلاةِ وواجِبِ الإنصافِ)
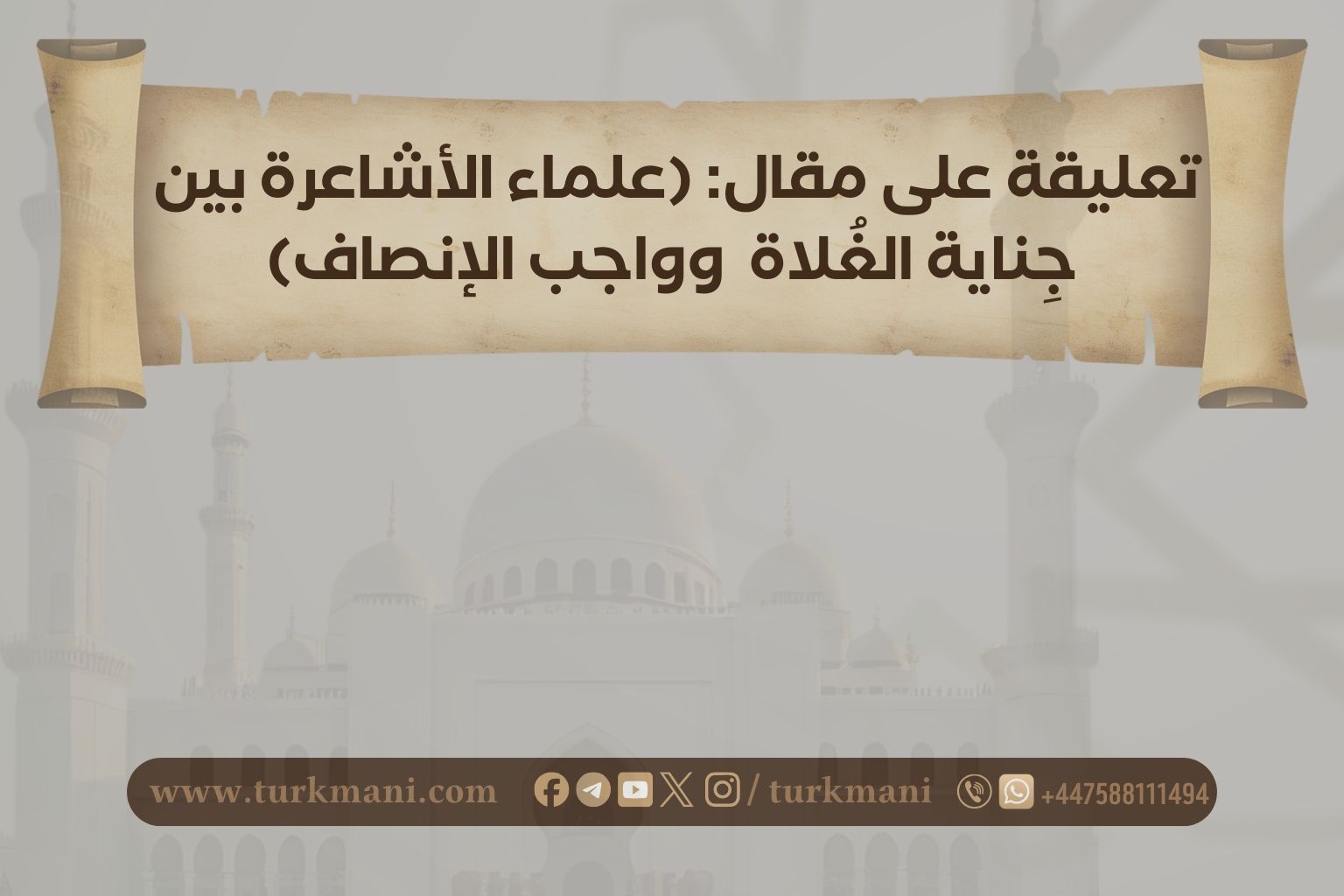
تعليقة على مقال: (علماء الأشاعرة بَينَ جِنايةِ الغُلاةِ وواجِبِ الإنصافِ)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقد اطَّلعتُ على مقال: (عُلماءُ الأشاعرة بَينَ جِنايةِ الغُلاةِ وواجِبِ الإنصافِ) لفضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقَّاف ـ وفقه الله وسدَّده ـ، وكما هو واضح من عنوان المقال، ثم من مضمونه؛ فقد قصد الشيخُ إنصاف «العلماء» الذين خالفوا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والاعتذار لهم، ومعالجة مشكلة الغلو في الموقف منهم، وتكفير أعيانهم.
لا شكَّ أنَّ قصدَ فضيلة الشيخ النصيحة والإصلاح ومعالجة مشكلة الغلو والانفلات العلمي غرضٌ نبيلٌ، وعملٌ مشكورٌ، ولا يلزم منه تزكية أهل الكلام والآخذين بمقولاتهم، فالمقصود التماس الأعذار للعلماء، وإنصافهم، ومنع البغي عليهم بالتكفير، وليس الثناء على من خالف طريقة السلف ومنهاجهم، ورفع شأنهم.
لقد استعمل الشيخ ـ وفقه الله وسدَّده ـ مصطلح: «علماء الأشاعرة» في دفاعه عن العلماء المتكلَّم فيهم وإيراده نصوص الثناء عليهم. والحقيقة أن هذا اصطلاح غير صحيح، وإنَّما يدَّعيه الذين يروِّجُون اليوم للعقيدة الأشعرية والبدع الكلاميَّة، وكذلك الذين يحاربون الدعوة السلفية لانحرافهم وحقدهم، كالدكتور حاتم العوني الذي يدَّعي أن علماء الأمة أشاعرة، بل «متكلِّمون» أيضًا، فلا يفرِّق بين الأشعري والمتكلِّم.
إنَّ الاصطلاح الصحيح في التعبير عن «العلماء» الذين هم محل البحث هو وصفهم بلقب: «علماء الشَّريعة»، وهم علماء التفسير والحديث والفقه واللغة، المتمايزون عن أهل الفلسفة والمنطق والكلام، وإن كان دخل عليهم قليلٌ أو كثيرٌ من مقولاتهم لأسباب موضوعية وتاريخية يطول شرحها.
أمَّا «علماء الأشاعرة» الذين هم علماؤهم حقيقةً؛ فهم «أهل الكلام»، كالجُويني والغزالي والشهرستاني والرازي والآمدي والإيجي، فهؤلاء أئمة الضَّلال الذين بثَّوا في الأمة علوم اليونان، وحكَّموها على الأصلين: القرآن والسنة، وعارضوا نصوصَهما بالتحريف والتأويل والتفويض. وقد نُقل عن أكثرهم في آخر عمرهم النَّدم والتَّوبة والرجوع إلى دين العجائز، ويقال: إنَّ الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره! ومهما اختلف الناس في الحكم على أعيانهم فإنَّ ذلك لا يغيِّر حقيقةَ أنهم خلَّفوا في المسلمين شرًّا عظيمًا.
وهؤلاء لا يتعلَّق بهم الاختلاف والجدل الحاصل بين طلاب العلم اليوم، وإنما الكلام في «علماء الشريعة» الذين هم علماؤها حقًّا وصدقًا، كابن الصَّلاح والنَّووي وابن حجر وأمثالهم.
قال أبو مسلمةَ: يمكن تمييز «علماء الشريعة» بجملةٍ من خصائصهم:
منها: أنَّ «علماء الشريعة» لا يُعرَفون في عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم إلَّا بعلوم الشريعة دراسةً وحفظًا وتدريسًا وتعليمًا واشتغالًا، وهم أهل التصنيف والتأليف والتدوين فيها، وتراثهم هو عمدة أهل الإسلام في علوم الشريعة، فلا يُعرفون بالاشتغال بالكلام، ولا التصنيف فيها، فإن كانت لآحادهم بعض الاهتمام بالكلام فهو اهتمام جزئي، ومشاركةُ أجنبيٍّ غير متخصِّصٍ.
ومنها: أنَّ «السنة النبوية والأحاديث والآثار» هي الحدُّ الفاصلُ والعلامةُ الفارقةُ بين الطائفتين:
أما «علماء الشريعة» فإنَّ من أبرز خصائصهم عنايتهم بالأحاديث والآثار روايةً ودرايةً ورعايةً وحفظًا وتدوينًا وشرحًا، وهذا ظاهر جدًّا في آثار ابن الصلاح والنووي وابن حجر وأمثالهم من «علماء الشريعة»، بل ما رفع الله ذِكْرَهم في الأمَّة، ولا طيَّب آثارهم، ولا كتب لهم القبول إلا بتعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلهم أعمارهم ـ كلَّها ـ في حفظه وخدمته.
أما «أهل الكلام»؛ فمن نظر في تراجم أشهر «علماء الأشاعرة» الذين ذكرتُهم آنفًا ـ أعني: الجويني والغزالي والشهرستاني والرازي والآمدي والإيجي ـ ودرس علومهم وعرف آثارهم؛ يجد أنَّهم كانوا أبعد الناس عن السنة وعلومها، وعن معرفة الأحاديث والآثار، بَلْهَ التمييز بين صحيحها وضعيفها. وأنَّ جهلهم بالحديث النبوي وعلومه سمةٌ بارزةٌ لهم، وصفةٌ مشتركةٌ بينهم. لا خلاف في هذا بين العارفين بحالهم من العلماء والباحثين.
سبحان الله! هذا موضع يحتاج إلى وقفة تأمل وعظة واعتبار.
ومنها: أنَّ موقفَ جميع «علماء الشريعة» ـ من المحدثين والفقهاء والقُضاة والمفتين ـ من الفلسفة والكلام ومن الفلاسفة والمتكلمين هو موقفٌ أقلُّ ما يقال فيه: «إنه سَلْبيٌّ» كما يعبِّر عن مثله أهلُ عصرنا، ترجمةً للكلمة الإنكليزية (negative)، ويقصدون بذلك عدم الاستحسان أو الرفض أو المعارضة، أو على الأقل التجاهل والإعراض، وكل هذه المعاني موجودة في مواقفهم المتفاوتة قوةً وضعفًا من الكلام وأهله، لكنها جميعًا في دائرة «السَّلْبيَّة».
ومنها: ترددهم واضطرابهم وتناقضهم في أخذهم بعقائد المتكلمين، وتسليمهم لها.
ونستطيع أن نضرب هنا مثلًا بالعالمَيْن الشهيرَيْن ـ اللَّذين يكثر ذكرهما في هذا المقام ـ: النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، فجميع ما ذكرته أعلاه ينطبق عليهما، وهما في الدرجة العُليا من الإمامة في علوم الشريعة، خاصة الحديث والفقه، وربما لا توجد على وجه الأرض مكتبة شرعية لا تحتوي على بعض مؤلفاتهما، فليس لطلاب العلم الشرعي غنًى عنها، ورغم كثرتها وتنوع موضوعاتها فليس فيها كتابٌ واحدٌ في الفلسفة أو المنطق أو الكلام، ولم يؤلِّفا كتابًا مفردًا في تقرير «العقيدة الأشعرية».
أما موقفهما «السلبيُّ» من (الكلام)؛ فمشهور معلوم، سواء في ثنايا كتبهما، أو في سيرتهما وأخبارهما.
وأذكر مثالًا ثالثًا من مقال الشيخ علوي السقَّاف نفسه، يبيِّن أهمية هذا التفريق والتمييز بين «علماء الشريعة» من حيث كونهم طائفةً لها منهجها وخصائصها، وبين «أهل الكلام» الذين هم طائفة مخالفة للأولى في منهجها وخصائصها؛ فقد ذكر فضيلةُ الشَّيخ مبحثَ: (ثناء علماء أهل السنة والجماعة على علماء أشاعرة بأعيانهم)، ثم ذكر منهم: الشيخ المحدِّث الفقيه أبا عمرو ابن الصَّلاح (ت: 643).
قال أبو مسلمةَ: هذا خطأ، وفيه ظلمٌ لهذا الإمام الجليل من «علماء الشريعة»، ويكفي أن نذكر هنا أنَّ جميع مؤلفاته إنَّما هي في الحديث والفقه والتاريخ والتراجم، وليس له علمٌ ولا مشاركةٌ في «الكلام» ـ بَلْهَ الفلسفة والمنطق ـ.
لقد سُئل ابن الصَّلاح عن «الحرف والصوت والاستواء» فكان من جوابه:
«إنَّما يجب عليهم أولًا أن يعتقدوا أنَّ لله تبارك وتعالى كل صفة كمال، وأنه مقدس عن كل صفة نقص، منزه عن كل تشبيه وتمثيل، وليقولوا عن اعتقاد جازم: آمنا بالله وبما قال الله على المعنى الذي أراده، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جامع جمل الإيمان إذا أتوا به فقد وفوا بما كلفوا به من ذلك، وليس من الدِّين الكلام في الحرف والصوت والاستواء وما شابه ذلك من كلِّ تعرُّضٍ لشيءٍ من كيفيَّة صفات الله تبارك وتعالى، بل ذلك من مصائب الدِّين، وآفات اليقين، وهو زيغ عظيم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، وسائر أئمة المتقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السالفين والخالفين رضي الله عنهم أجمعين. وسبيل من أراد سلوك سبيلهم في هذه الأمور، وفي سائر الآيات المشتبهات، والأخبار المشتبهة، أن يقول: هذه لها معنًى يليق بجلال الله وكماله وتقديسه المطلَق، اللهُ العالم به، وليس البحث عنه من شأني، ثم يلازم السكوت في ذلك، ولا يسأل عن معنى ذلك، ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة...».
قال أبو مسلمةَ: من الواضح أنَّ جواب ابن الصلاح جاء على طريقة «الفقهاء» ولغتهم، لا على طريقة «أهل الكلام» ولغتهم، بل هو قريب جدًّا من طريقة السَّلف وأئمة السنَّة ولغتهم لولا ما فيه من التفويض. لهذا فقد ذكر جامعُ فتاويه تلميذُه إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربيُّ (ت: 650) أن جواب شيخه هذا أثار غضب أحد المتكلمين، فقال: «ولما وقف عليه ذلك الرجل ثار فبدَّع وشنَّع وافترى وأفحش، وزعم أنه لا بدَّ من الخوض والتَّفصيل، ونسب شيخنا إلى الحشو». ثم أجاب المغربي دفاعًا عن شيخه: «وسبحان الله! كيف يكون حشوًا، وهو سبيل سلف الأمة وساداتها، ومذهب الأئمة أرباب المذاهب فقهاء الملَّة، لا سيما الشافعي وشيخَيْ أصحابه: المزَنيُّ وابن سُرَيجٍ، فأخبارهم وكتبهم ناطقةٌ بمبالغتهم في ذلك، وتشديد الإمام الشافعيِّ على من حادَ عن هذا معروف مشهور، وما للبيهقي فيه من تأويلٍ وتخصيصٍ فهو غفلةٌ منه وذهول، وفي كلام الشافعيِّ في مواضع عدَّة ما يوضح بطلان تأويله، ولم يزل على ذلك اختيار كبار فقهاء المسلمين وجميع صالحيهم، والمتكلمون من أصحابنا لا يقدحون في هذه الطريقة، وإن كان الخوض شغلهم، فهم يرون جوازَ الخوض من غير قدح في هذا، بل يرونه أولى لمن سَلَّم له، وأسلَمَ للعامة ولأكثر الناس، وهذا الإمام الغزالي قد صنَّف في تقرير مثل هذا الجواب الذي أجاب شيخنا كتابًا هو آخر تصانيفه سماه «إلجام العوام عن علم الكلام»...» إلى آخر كلام المغربي. (فتاوى ومسائل ابن الصلاح، دار المعرفة، بيروت: 1406، 1/115)
قال أبو مسلمةَ: كلام تلميذ ابن الصَّلاح مفيد جدًّا في تمييز طريقة «علماء الشريعة» عن طريقة «أهل الكلام»، وأن فقهاء الشافعية كانوا يرون «المتكلمين» المنتسبين إلى مذهبهم طائفة خاصة، يخالفون طريقة عامة الفقهاء بالخوض في الكلام والتأويل. ومن الواضح من مجمل السياقات التاريخية أن «المتكلمين» قد رضوا من الفقهاء التفويض أو الإثبات المجمل، مقابل قبول انتسابهم إلى مذهبهم الفقهي، وهو الانتساب الذي يمنحهم القبول لدى العامة الذين ينفرون من الكلام وأهله. وتشكَّلت هذه الموازنة بين الطرفين بعد صراع مرير بينهما، كانت الغلبة فيها للمتكلمين من جهة تأييد الحكام لهم وتوليهم الأوقاف والمدارس، وكانت القوة الدينية الفعلية لدى «علماء الشريعة» من خلال حملهم للأمانة الدينية وصلتهم بعامة المسلمين. وفهم هذه التفاصيل التاريخية يعين على بناء التصور الصحيح لهذه المشكلة.
وأيضًا: كيف يصحُّ ذكر الإمام ابن الصلاح في «علماء الأشاعرة» وقد اشتهر عنه: «أنه أمر بانتزاع مدرسةٍ معروفةٍ بدمشق من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضلُ من أخذ عَكَّا» (الانتصار لأهل الأثر: 267).
وأبو الحسن الآمديُّ (ت: 631) من أئمة الأشاعرة المتكلِّمين، ومن مؤلِّفاته على طريقتهم: «غاية المرام في علم الكلام»، فلم يكن فيلسوفًا ولا معتزليًّا.
وعكَّا مدينة في فلسطين كانت في ذلك الوقت تحت احتلال الصليبيِّين. فلو أنَّ أحد الشباب المتحمسين لعقيدة السلف اليوم قال مثل هذه الكلمة لتوجَّهت السِّهام إليه بالتُّهم الشنيعة!
وللإمام ابن الصلاح رحمه الله فتوى قويَّة في النهي عن المنطق والفلسفة لا يمكن أن تصدر مثلها عن «أشعري متكلِّم» ـ فالمنطق خاصَّةً من الأدوات الضرورية للمتكلم ـ، وقد ذكر فيها تمايز طريقة «علماء الشريعة» عن طريقة مخالفيهم، فقال:
«قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم، والسبيل الأسلم الأطهر كلَّ صحيح الذهن، لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها، وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان، ومكر به، فالواجب على السلطان ـ أعزَّه الله وأعزَّ به الإسلامَ وأهلَه ـ أن يدفع عن المسلمين شرَّ هؤلاء المشائيم، ويُخرجهم من المدارس ويُبعدهم، ويعاقب على الاشتغال بفنِّهم، ويَعرِضَ من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام، لتخمد نارهم، وتنمحي آثارها وآثارهم، يسَّر الله ذلك وعجَّله، ومن أوجب هذا الواجب: عزْلُ من كان مدرِّس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها، والإقراء لها، ثم سجنه وإلزامه منزله. ومن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن حاله يكذبه، والطريق في قلع الشر قلع أصوله، وانتصاب مثله مدرسًا من العظائم جملةً» (فتاوى ابن الصلاح: 1/261).
قال أبو مسلمةَ: لو كان هذا الإمام الفقيه في زماننا لعيَّره أهل البدعة بأنه: (جاسوس، عميل، مخابرات، من علماء السلطان)!
قال أبو مسلمةَ: هذه نبذة يسيرة أردت بها التنبيه على ضرورة معالجة مشكلة الكلام في «علماء الشريعة» على أساس التمييز بينهم وبين «أهل الكلام» أولًا، ثم استحضار الأسباب العلمية والموضوعية والتاريخية التي أدَّت إلى تسلُّط أهل الكلام على «علماء الشريعة»، وإلى تمكُّنهم من إضعاف حصانتهم ومقاومتهم. وقد أسَّسْتُ لهذه الرؤية في أحد مباحث كتابي: «حقيقة توحيد العبادة»، وذكرتُ جملةً من الأمثلة من مواقف «علماء الشريعة»، وسأفرده بالنشر مع زيادات كثيرة في التأصيل والتفصيل والاستشهاد، إن شاء الله تعالى. ذلك لأنني أعتقد أن من أهم أسباب ما نراه اليوم لدى بعض إخواننا الشباب ـ من الجيل الجديد الذين هداهم الله تعالى إلى التوحيد والسنة وعقيدة السلف الصالح ـ من الخلل والاضطراب في مواقفهم وأحكامهم على «علماء الشريعة»؛ عدم وضوح هذا التمييز في أذهانهم، وقلة معرفتهم بالسياقات العلمية والموضوعية والتاريخية التي عانت منها الأمة منذ انقضاء القرون الثلاثة الأولى، وكان من آثارها تمايز «علماء الشريعة» والتشكُّل المعرفي والثقافي والسلوكي لهم، مما أبرز إشكاليَّةً ظاهرةً في إمكانية التعامل مع هذه الطائفة العظيمة من حملة العلم وأنصار الشريعة بنفس طريقة أئمة السَّلف في القرون الأولى في مواجهتهم لأهل البدع والضلالة، فكان لا بدَّ من توظيف السياسة الشرعية في العلم والدعوة والإصلاح، وهو ما ظهر جليًّا في الدعوة الإصلاحية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسار عليه الإصلاحيون من بعده، من الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، إلى أولاده وأحفاده وسائر العلماء من حملة دعوة التوحيد والسنة، وعلى هذا أدركنا علماءنا ومشايخنا، رحم الله أمواتهم، وحفظ أحياءهم، وثبَّتنا وإياهم على الحقِّ والهدى، بمنِّه وكرمه. آمين، آمين، والحمد لله ربِّ العالمين.
كتبه:
أبو مسلمةَ عبد الحق بن ملا حقي التركمانيُّ
الأحد 8 ربيع الأول 1447، الموافق: 31 آب 2025
- لا يوجد تعليقات بعد