سبع إضاءات إسلامية حول العملية الانتحارية في ستوكهولم
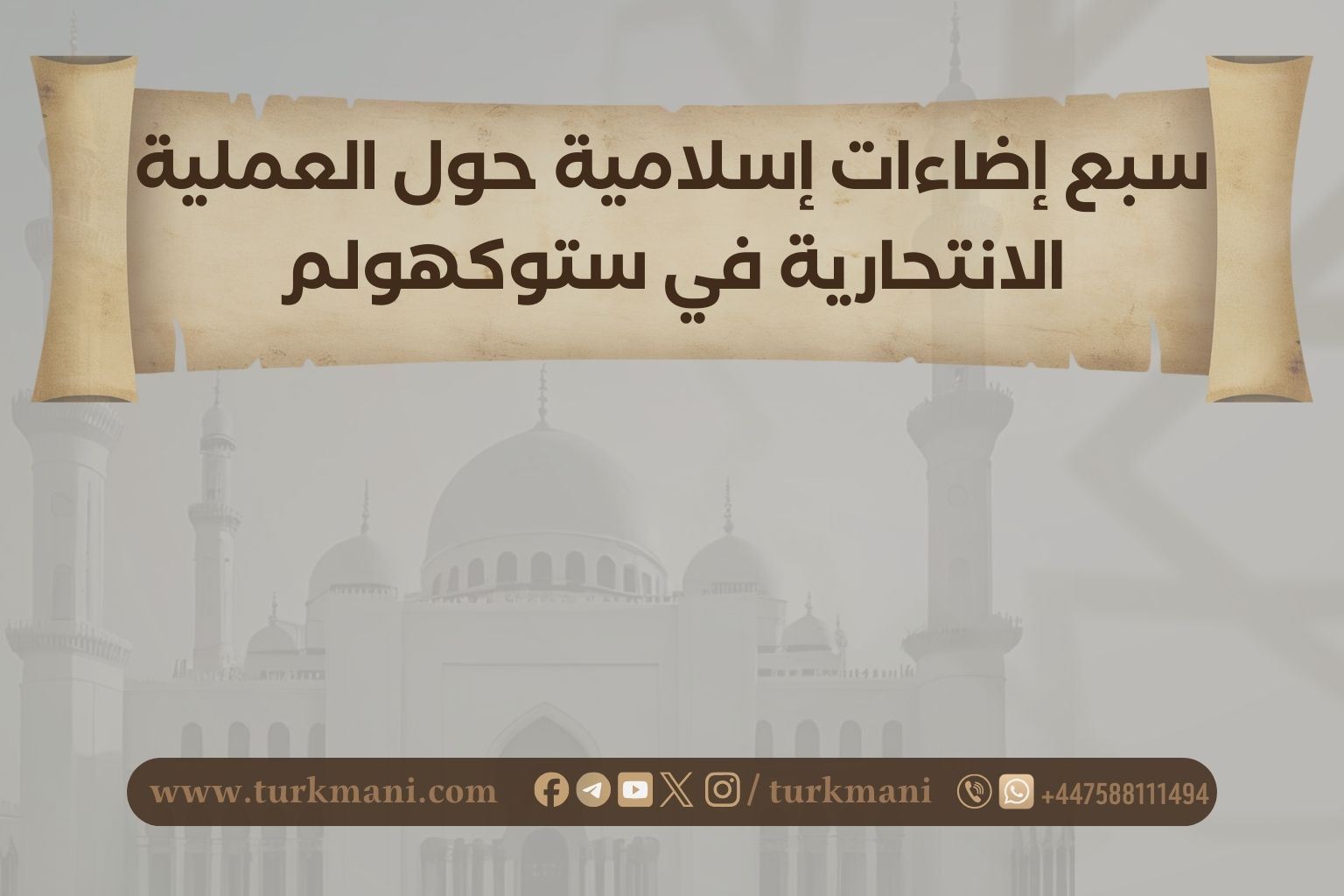
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين[1].
أما بعد:
فهذه كلمات حول العملية الانتحارية التي وقعت في ستوكهولم مساء يوم السبت: 11/12/2010م؛ لا نريد من خلالها أن نثبت إدانتنا واستنكارنا لهذه الجريمة الشنعاء فحسب، لأنَّ هذا أقلُّ ما يوجبه علينا دينُنا الحنيف، بل نريد الإشارةَ بإيجاز إلى بعض النقاط المعينة في فهم سبب تورُّط بعض المسلمين في الأعمال الإرهابية والانتحارية، وحكم الإسلام فيها:
1- ليس صحيحًا ما يدعيه بعض الناس من أن منفذي هذه العمليات يعانون من أمراض نفسية، وربما يكونون تحت تأثير المخدِّرات، بل الحقيقة أنهم يتمتعون بالذكاء والصحة العقلية والنفسية، وكثير منهم يحملون شهادات دراسية عالية، فهم ينفذون هذه العمليات بقناعة ذاتية، وإرادة قوية، واختيارٍ جازم، ونفس راضية مطمئنة. وقد حدثنا القرآن الكريم عن قومٍ مقاصدهم حسنة ـ في ظنِّهم ـ، يقومون بأعمال جليلة، لكنهم لا يسلكون الصراط المستقيم الذي بيَّنه الله لهم، فيكونون يوم القيامة أشدَّ الناس خيبةً وخسرانًا: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103-104]. ونقرأ في تاريخ الأديان أن تعذيب الإنسان نفسَه بالتجويع والضرب وإسالة الدم والانتحار؛ كان معروفًا في أتباع بعض الديانات، ونجد أن (الجاينية – Jainism) في الهند يلجؤون ـ أحيانًا ـ إلى قطع الروابط بالحياة عن طريق الانتحار، ويعتبرونه غاية لا تتاح إلا للخاصة من الرهبان!
2- إن العقيدة التي تدفع إلى عملية انتحارية هي في حقيقتها تفسير منحرف وضال للدين ومقاصده. والدين هو أصل كل خير وبرٍّ وخُلُقٍ حسن في الناس، لكنه عندما يحرَّف يتحول إلى دافع قويٍّ للشرِّ والبغي والظلم والفساد، وظهور بعض الفرق المنحرفة عن حقيقة الدين ليس خاصًّا بالإسلام، بل وُجد ويوجد في كلِّ دين، وكم شهدت أوروبا ـ وغيرها ـ من حروب وقتل وتعذيب واضطهاد باسم الدين، ويبقى التاريخ الإسلامي هو الأصفى والأنقى والأبعد ـ في تاريخ البشرية كلها ـ عن الظلم والاضطهاد باسم الدين، والسبب في ذلك أن المصدرين الرئيسين للإسلام ـ وهما القرآن والسنة ـ محفوظان مصونان حتى اليوم، وهما المرجعيتان الوحيدتان لعلماء الإسلام الكبار، الذين قاموا بواجبهم عبر العصور المختلفة، ودون انقطاع، لمنع تحريف الدين، وفضح حركات التحريف ومقاومتها بالحجة والبرهان، ومحاصرة فكرها حتى لا يفسد المجتمعات الإسلامية. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بظهور الحركات التحريفية، وبيَّن في أحاديث كثيرة ـ تُعرف بأحاديث الخوارج ـ خطورتَها على الدين والمجتمع والكيان الإسلامي، لهذا أمر المسلمين بمحاربتها من غير هوادة، وحذَّرهم من التعاطف مع أتباع تلك الحركات رغم إكثارهم من الصلاة والصيام وقراءة القرآن!
3- لقد كان المسلمون يدركون منذ فجر الإسلام وعبر عصوره المختلفة بأنَّ الإسلام: دينٌ يقصد به إخلاص العبادة لله تعالى، ونفي الشرك، والقيام بالواجبات الدينية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والالتزام بالأخلاق الفاضلة، والتقيد بأحكام الشريعة في الحلال والحرام. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بالدين كله، وهو في الآخرة من أهل الجنة، أما ما يحصل، وما يجب أن يحصل بسبب الدين من تغيير في السياسة والاقتصاد والاجتماع فإنما هو من نتائج الدين وثماره وآثاره، وهي غير مقصودة لذاتها، لكن يمكن أن تكون مطلوبة من باب تحقيق النتائج والثمار.
وقبل نحو مئة سنةٍ ظهر تفسير جديد للإسلام، خلاصته: أن الإسلام مشروع ماديِّ حضاري يقصد به تغيير أنماط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، وأن ما يتضمنه من العبادات والشرائع الدينية الخالصة ليس هي المقصد الأساس من الدين، بل هي وسائل غير مقصودة لذاتها.
لقد أحدث هذا التفسير الجديد للإسلام ثورة في كيان العالم الإسلامي، وتسبَّب في قلب كثير من المفاهيم حول حقيقة الدين، وولَّد تشوُّهًا وتشوشًا لدى كثير من المسلمين في فهم الغاية منه وما يقصد به، وكان سببًا لكثيرٍ من الثورات والفتن الداخلية.
لقد صار كثير من المسلمين ـ من الذين حملوا هذا التفسير، أو تأثروا به وهم لا يشعرون ـ يعتقدون أن الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك من الشعائر التعبدية، لا معنى لها، ولا فائدة منها؛ إن لم تترك أثرًا ظاهرًا، ولم تحقق تغييرًا بيِّنًا في واقع الحياة، لهذا صاروا ينظرون إلى العبادات والشعائر نظرة باردة لا تخلو من امتهان واستخفاف، ونتيجة لهذا لم يعُدْ من المهم لديهم العناية بها علمًا وعملاً وتعليمًا ودعوةً، ونتيجة لهذا أيضًا: تطاولوا على علماء الإسلام، وسلطوا ألسنتهم عليهم بالسباب والشتائم والتحقير والاتهام بالخيانة والكفر.
ولا شكَّ أن العمليات الانتحارية هي من المفاسد الكثيرة لهذا التفسير الجديد للدين، فالشاب الذي يتوجَّه إلى عبادة الله تعالى، تدفعه رغبة صادقة في التقرب إلى خالقه، وطلب مغفرته ورحمته، إنه ببراءة عقله وسلامة فطرته يعلم أن (الدين الحقَّ) إنما هو: الذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن والأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة. لكن هذا الشاب سيفاجأ ـ إن وقع في أحضان جماعة تؤمن بالتفسير الجديد للدين ـ بتفسير مختلف تمامًا عمَّا هو راسخ في أعماقه، حيث يُقال له: (إنَّ الغاية من الدين تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي في العالم، وإنه لا معنى للصلاة ولا للصيام ولا لقراءة القرآن وتعلم أحكام الدين إن لم نقم بذلك. وهؤلاء الذين تراهم يصلون ويصومون، حتى العلماء والدعاة، بل حتى المؤذنون الذين يدعون الناس إلى الصلاة خمس مرات في اليوم، هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين، بل هم كفار مرتدون، لأنهم لا يقومون بحقيقة الدين، وغاية أمرهم أنهم يُلهون أنفسهم بالصلاة وقراءة القرآن وكتب الحديث)!
فإذا اقتنع الشاب بهذا التفسير سيطر على تفكيره هدفُ تغيير العالم، فلم يعبأ بصلاة ولا بغيرها من العبادات والأعمال الصالحة، ونفر عن تعلم أحكام الدين والاستماع إلى العلماء نفرةً تامةً، فيسعى بعد هذا إلى تحقيق ذلك الهدف، فإذا به يصدم بواقع يجد نفسه عاجزًا عن تغييره، فيقع في اليأس، ويشعر بالإحباط، ويصبح ناقمًا على الناس أجمعين، فتتحكَّم فيه الرغبة في الانتقام، فيقرِّرُ ـ بعد صراع نفسي ثقيل ـ أن ينفذ عملية انتحارية، ليس فيها معنًى سوى الرغبة في الانتقام، وإن كانت ضحاياه من المدنيين الأبرياء، فحسبه أن يثبت أنَّه كان صادقًا في تنفيذ مشروع تغيير العالم، فيكون ممن قام بالدين، فيجازيه الله تعالى بالجنة ونعيمها!
4- إننا عندما ندين ونتبرأ من هذا الفعل، فإنَّنا ندين ونتبرأ من كلِّ من تورط فيه سواء بالتنفيذ أو بالمساعدة والدعم، أو بالتوجيه والتشجيع، أو بالموافقة والتأييد، وقد كان منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا واضحًا: إنَّه كان دائمًا يؤكِّد على إدانة الفعل والفاعل معًا وإن كان الفاعل مسلمًا ـ إلا إن كان معذورًا بعذر مقبول، ولم يتعمَّد الإساءة ـ، لأن إدانة الفعل مع البحث عن الأعذار للفاعل، ومحاولة التسويغ لجنايته؛ إنما هو من التلون والنفاق. وأكتفي هنا بذكر حديث واحدٍ من الأحاديث الدالَّة على هذا المعنى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما رَجُلٍ أَمَّنَ رجلاً على دَمِهِ ثُمَّ قتَلَه، فأَنَا مِنَ القاتل بَرِيءٌ، وإنْ كان المقتولُ كافرًا» [أخرجه أحمد وصححه الألباني]، فهذا في خيانة رجل واحد، فكيف فيمن خان المجتمع الذي ينتمي إليه، وقد حظي برعايته، وتخرج من مدارسه، وتقلَّبَ في إحسانه، والله تعالى يقول: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]؟!
5- إنَّ رفضنا لهذه الأعمال الإرهابية يجب أن لا يستند إلى تحريم العمليات الانتحارية وتحريم استهداف المدنيين فحسب، بل لا بدَّ أن يستند إلى رؤية شاملة للإسلام وحقائقه، من حيث كونه دينًا يأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، ويحرِّم الظلم والغدر والخيانة، ويضع أسسًا قوية للتعايش الإنساني رغم الاختلاف في الدين، ويحصر القتال في ساحة الحرب، ويجعل لها أحكامًا وأخلاقًا وآدابًا لازمة حتى لا تتحول الحياة إلى ساحة معركة، ولا يفقد الناس أخلاقهم ومشاعرهم مهما استحكم العداء والبغضاء في قلوبهم. إن الأحكام التفصيلية التي تقرِّر هذه القواعد الأخلاقية كثيرة جدًّا في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسأكتفي هنا باستشهادٍ واحدٍ من القرآن الكريم، يمثِّل صدمةً لكثيرٍ من المسلمين قبل غيرهم، لأنهم يجهلونه، ولا تطيق مشاعرهم وعواطفهم هذا الانضباط السَّامي رغم قسوة الموقف:
يقول الله تعالى في سورة الأنفال، الآية (72): {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
لقد كانت الهجرة إلى المدينة ـ قبل أن يتمكن المسلمون من فتح مكة ـ واجبة على كلِّ من يسلم في الجزيرة العربية، فكان الذين يسلمون ولا يهاجرون يُحرمون من حقوق وامتيازات الانتماء إلى دولة المدينة، إلا في شيء واحد: وهو طلب النصرة والعون في مواجهة اعتداء عليهم بسبب انتمائهم إلى الإسلام، فحينئذٍ يجب على المسلمين في المدينة الاستجابة لطلبهم لما بينهم من رابط الديانة الذي هو سبب الاعتداء، إلا إن كان بين المسلمين وبين أولئك الأعداء المعتدين معاهدة صلحٍ وهدنةٍ، فلا يجوز للمسلمين في هذه الحالة نصرة إخوانهم المسلمين، لما في ذلك من نقض العهد، والغدر والخيانة، فيجب عليهم أولاً ـ إن أرادوا الدخول في الحرب ـ إبلاغ الطرف الآخر بإلغاء المعاهدة بشكل واضح وصريح، كما جاء في موضع سابق من هذه السورة في الآية (58): {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}.
لقد التزم المسلمون ـ يوم كانوا يتبعون دينهم عن علم وفقه، لا عن تقليد وعاطفة ـ بهذا الأمر القرآني، واستخرجوا منه أحكامًا لوقائع أخرى أشدُّ قسوةً على قلوبهم، وأضرب لهذا مثالاً واحدًا من كلام أحد أئمة الإسلام الكبار: الإمام الشافعي (ت: 204 هـ/820م) رحمه الله، حيث قرَّر في كتابه (الأُمُّ) ـ الذي يعدُّ من أهم كتب الفقه الإسلامي ـ ما يلي:
(وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمانٍ، فسبَى أهلُ الحرب قومًا من المسلمين؛ لم يكن للمستأمَنين قتال أهل الحرب عنهم، حتَّى يَنْبِذُوا إليهم، فإذا نَبَذُوا إليهم فحَذَّروهم، وانقطع الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمَّا ما كانوا في مدَّة الأمان فليسَ لهم قتالُهم).[الأم: 4/375].
(إذا دخل قومٌ من المسلمين بلادَ الحرب بأمانٍ؛ فالعدوُّ منهم آمنون إلى أن يفارقوهم، أو يبْلُغُوا مدَّةَ أمانِهم، وليسَ لهم ظُلْمُهم، ولا خيانَتُهم. وإن أَسَرَ العدوُّ أطفالَ المسلمينَ ونساءَهم؛لم أَكُنْ أُحبُّ لهم الغَدْرَ بالعدوِّ، ولكن أُحبُّ لهم لو سأَلُوهم أَنْ يَردُّوا إليهم الأمانَ، ويَنْبِذُوا إليهم، فإذا فعَلُوا؛ قاتلُوهم عن أطفالِ المسلمين ونسائِهم) [الأم: 4/248].
إن هذا النص القرآني يحتِّم علينا ـ نحن المسلمين المقيمين في دول غير إسلامية ـ أن نلتزم بعهد الأمان الذي دخلنا فيه، سواء بالإقامة المؤقتة، أو الدائمة، أو المواطنة ـ، ورغم أن طبيعة العلاقة بيننا وبين الدول التي نعيش فيها تختلف عن صورتها في العصور السابقة، حيث نعيش في دول علمانية لا تعاملنا على أساس الدين، ونحظى بحقوق المواطنة كاملة، فإن الحكم الديني والأخلاقي يبقى واحدًا، ولا يختلف في هذا أحدٌ من فقهاء الإسلام في هذا العصر. فيجب علينا الوفاء بالعهود والمواثيق، ويحرم علينا الغدر والخيانة. كما يحرم علينا ـ بنصِّ القرآن الكريم ـ أن نكون طرفًا في حربٍ ضد الدول التي نقيم فيها، حتى وإن كان هدفنا نصرة إخواننا المظلومين في الدين. ومن اختار من المسلمين أن يتصرف بما ينافي هذا، فيجب عليه أولاً ـ بنص القرآن الكريم ـ أن يبلغ الجهات الرسمية في الدولة التي يقيم فيها، تبليغًا صريحًا واضحًا بأنه اختار التخلي عن الجنسية التي يحملها أو الإقامة التي يتمتع بها، وأنه يقطع علاقته بتلك الدولة، ويُعلن أنه في حالة حرب معها. ويجب عليه ـ بنص القرآن الكريم ـ أن يتأكَّد من أن الجهات الرسمية قد علمت ببلاغه، وفهمت مراده، وصارت على بيَّنة من قراره واختياره. هذا هو حكم القرآن، وأخلاق أهل الإسلام. وهذا لا يعني أن من فعل هذا يصبحُ حرًّا في تصرفاته، لأنَّ للحرب والمواجهة أحكامًا دينية، وضوابط أخلاقية كثيرة لا بدَّ من الالتزام بجميعها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدَّم.
6- لقد عمد بعض المغرضين إلى ربط هذا العمل الإرهابي بـ: (السلفية) و(السلفيين)، والدعوة السلفية منهجها واضح لا غموض فيه، وهو اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة وأئمة الإسلام الكبار، ومن هنا فإن السلفيين يتبرؤون من الغلو في الدين ومن الإرهاب والتفجير، لأن هذه الأعمال الإجرامية لا يقرُّها دين الإسلام، وهي مضادة لأحكام وتعاليم القرآن والسنة، ولفتاوى علماء الإسلام السلفيين، وأشهرهم في هذا العصر: ابن باز، وابن عثيمين، والألباني. ولهم فتاوى كثيرة مشهورة ضد العنف والإرهاب وجماعات الغلو والتطرف.
7- إن على أئمة المساجد والناشطين في الدعوة ومسؤولي المؤسسات والمراكز الإسلامية مسؤولية كبيرة في بيان هذه الأحكام، والجهر بها، وشرحها بالتفصيل للمسلمين وغير المسلمين. وإنه لا عذر لأحدٍ في السكوت وهو يرى التحريف والهرطقة باسم الإسلام. وقد مدح الله تعالى المؤمنين الصادقين بأنهم: {يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب: 39]، وحذَّر من كتم العلم فقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159]. وبالله تعالى التوفيق.
كتبه:
عبد الحق التركماني
رئيس مركز البحوث الإسلامية في السويد
غوطبورغ في 16/12/2010م
المقال مترجم إلى الانجليزية على الرابط: اضغط هنا
Article translated to English, click here
1) تنويه: كتب هذا المقال لغرض ترجمته إلى اللغة السويدية، لهذا قد يبدو ركيكًا في بعض عباراته.
- لا يوجد تعليقات بعد
