فتنةٌ ولا أبا الحسَنِ لها (1)
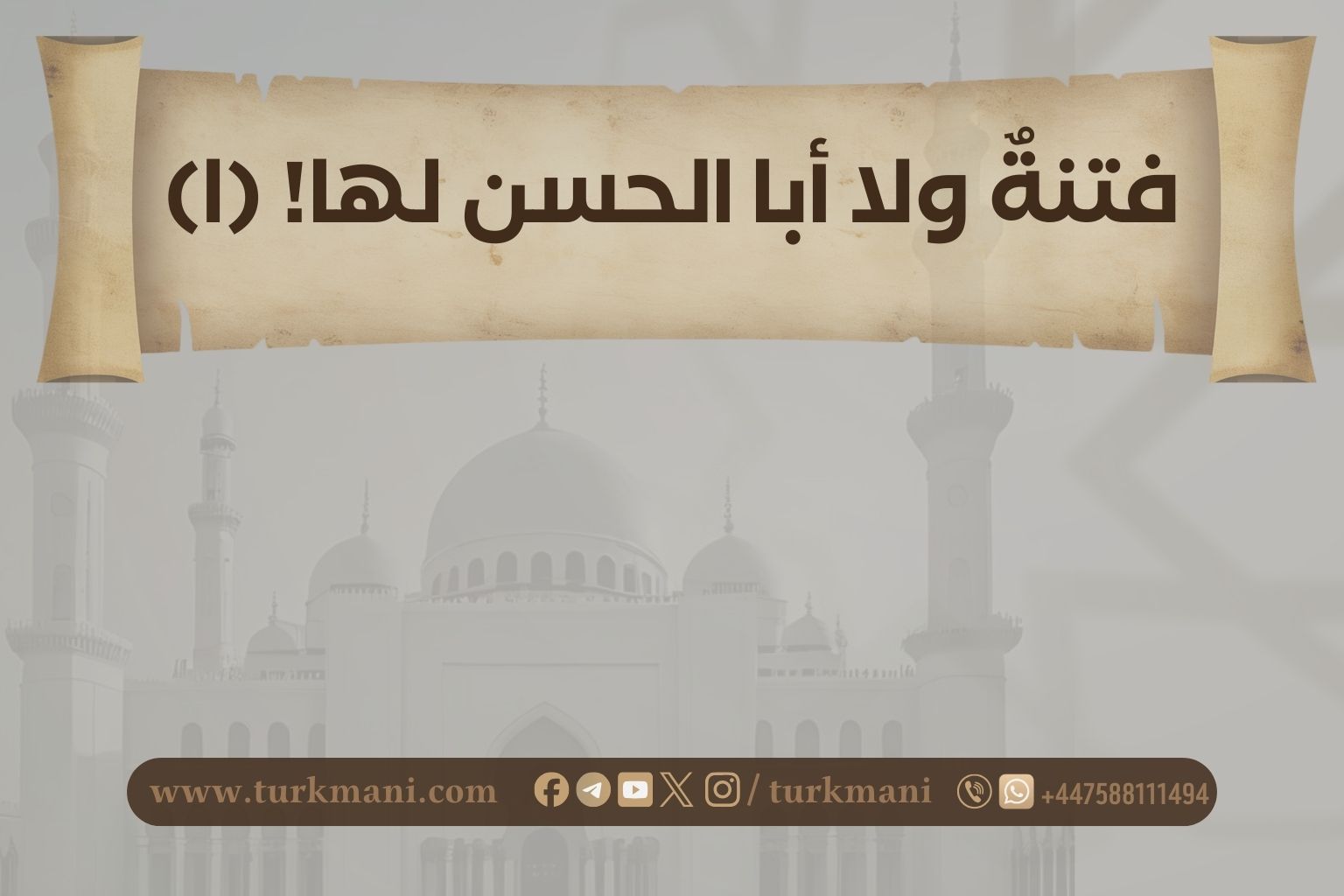
يعيش العالم العربي ـ وهو قلب العالم الإسلامي ـ في هذه الأيام فتنةً عظيمةً، لم يشهد مثلها في العصر الحديث إلا بعد ثورة (1952م)، عندما تحالف الإخوان المسلمون مع اليساريين والاشتراكيين فأسقطوا بالغدر والخيانة النظام الملكي في مصر، واجتاحت العالم العربي التيارات القومية والاشتراكية والشيوعية المارقة. واليوم يختار الإسلاميون الحركيون مرة أخرى أن يكونوا نار الفتنة الجديدة ووقودها.
إنني لا أقصد فتنة سفك الدماء والإخلال بالأمن وفوضى المظاهرات والاعتصامات والثورات المتلاحقة، بل فتنة أخرى أعظم من ذلك كله وأخطر: إنها فتنة تحريف الدين، ونسف ثوابته، وتغيير المعتقدات والمفاهيم والأفكار، وتدمير خصائص الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم؛ بالدعوة الصريحة إلى الأصول الكلية للفكر الغربي وفلسفته الإلحادية: الحرية والديمقراطية والتعددية وسلطة الشعب والتحاكم للعامة والتشغيب على سلطان الدولة بتحريك الجماهير وتجريد الحاكم من صلاحياته وعدم الصبر على ما يكون منه من ظلم وجور، وإسقاط رسالة الأمة ومصالحها العليا… فالقضية أعظم من حكم المظاهرات: هل هي جائزة أم محرمة؟ ومن حكم الخروج على الحاكم: متى يكون؟ وكيف يكون؟ إنها قضية الخروج على الشريعة، وتحطيم الخصائص الدينية لهذه الأمة، فماذا يكون بعد أن صار ديدن الإسلاميين وأكبر همِّهم الدعوة إلى الحرية والتعددية والحياة المدنية ومحاسبة الحاكم على كل صغيرة وكبيرة، وعلى تقييد صلاحياته، وتحديد سنوات حكمه، وتقرير هذه الأمور على أنها من المسلَّمات ومن ضروريات حقوق الإنسان؛ فأين كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تلك المسلمات والضروريات عندما أمر أمته ـ كما في أحاديثه الصحيحة المتواترة، القطعية في ثبوتها، والقطعية في دلالتها ـ بالصبر على جور الحكَّام مهما بالغوا في الظلم والاعتداء ما لم يظهروا كفرًا بواحًا؟! أم أن تلك الأحاديث ـ وهي كثيرة متواترة ـ قد اختلقها الفقهاء في عهد بني أمية ليسوِّغوا ظلمهم ويسكِّنوا الناس عن الثورة عليهم ـ كما زعم المستشرقون الحاقدون ـ وحينئذٍ تكون السنة النبوية كلها موضع شكٍّ وارتياب؟! وأين كان أهل السنة والجماعة من تلك المسلَّمات والضروريات حينما قرَّروا في كتبهم في الاعتقاد أن: (الصبر على ظلم الأئمة وجورهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة) ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 2/179 ـ؟! وما شأنُ الخلفاء الراشدين ـ الذين هم خير البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ـ لم يترك أحدٌ منهم الحكم إلا بانقضاء أجله بالموت أو القتل رضي الله عنهم وأرضاهم؟!
في ظلِّ هذه الفتنة التي زلزلت ثوابت، وأضلت عقولاً كثيرةً، ومسخت قلوبًا ضعيفة؛ لا بدَّ أن ينبري العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى على منهاج النبوة لحراسة العقيدة والشريعة، والدفاع عن الأمة وخصائصها، ومواجهة هذا الزحف الجديد من الفكر الغربي اللاديني، الذي صار كثير من الإسلاميين ـ غير مأسوفٍ عليهم ـ في مقدمة مسوِّقيه ومروِّجيه. وإنَّ أحقَّ من يقوم بهذا الجهاد العظيم ـ وهو جهاد العصر، جهاد الدفع والضرورة ـ هم أهل التديُّن والتعظيم لشرع الله ودينه من جميع الفرق المنتسبة إلى السنة والجماعة عمومًا من أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية والصوفية وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات وخريجي المعاهد الدينية؛ من المتدينين الصالحين، ممن لم يتلوث فكرهم بالتفسير السياسي الحركي للإسلام، ولم تستحكم فيهم الشبهات والشهوات، بل هم متدينون على نهج السابقين من أهل الدين والصلاح، وإن وقعوا في قليل أو كثير من البدع والمخالفات في العقائد والعبادات، واختلفوا فيما بينهم في بعض الأصول والفروع مما يختلف فيه أهل الدين الواحد.
وأحقُّ هؤلاء جميعًا بهذا الجهاد هم أهل الحديث والأثر، السائرون على نهج السلف الصالح، فهم أولى الناس بالجهاد في كل ميدان، ولهم مآثرهم المشهودة في حراسة العقيدة وصد عدوان الفرق الضالة في كل عصر ومصر، فحري بعقلائهم وأهل العلم والهمَّة فيهم أن يتجاوزوا في اهتماماتهم ما انشغل به كلُّ أحمقٍ، محدود التفكير، ضيِّق العطن؛ مِن تتبع عورات المسلمين والكلام في فلان وعلان، وامتحان الناس بالأعيان، وتوكيل الأتباع السفهاء بإشعال الفتن في الآفاق، والترقِّي من التبديع إلى التكفير، حتى صاروا أضحوكة بين الناس!
هذا الجهاد يحتاج إلى علم شرعي، وفقه في الدين، وإطلاع على الفلسفات والأفكار، وقدرة على المحاججة وإقامة البراهين، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والاستفادة من كل جهد علمي وفكري رصين. وإن أول من يُستفاد من علمه وفكره وسابق جهاده في هذا الميدان هو العلامة أبو الحسن علي الحسني النَّدوي رحمه الله، الذي وصفه إمام العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بالكاتب الإسلامي الشهير، والعالم العربي الحسني الكبير (كما في مجموع فتاويه 1/288).
لقد كان الندوي عالمًا كبيرًا، فقيهًا في معرفة التاريخ والحضارات، دارسًا للفلسفات والأفكار، كبير العقل، زكي النفس، عالي الهمَّة، متين الديانة، زاهدًا في الدنيا، مشمرًا للآخرة؛ لكنْ زَهِدَ فيه كثيرٌ من السلفيين لتصوُّفه، وألَّف في ذلك الأستاذ صلاح مقبول ـ جزاه الله خيرًا ـ كتابًا قيِّمًا سماه: (الأستاذ الندوي: الوجه الآخر من كتاباته)؛ وهو كافٍ ووافٍ في دراسة ونقد صوفيات النَّدوي، ويظنه كثير من طلبة العلم من الإخوان المسلمين، ولم يكن إخوانيًّا قطُّ، وإنما كان وثيق الصلة بكثير من شخصياتهم، لهذا أثنى على بعضهم، فصار أولئك يدَّعون نسبته إليهم، مع أنه كتب الكثير مما ينقض ويناقض فكرهم، وألَّف أهمَّ كتاب في العصر الحديث في فضح الفكر الحركي كاشفًا خطره على مستقبل الإسلام، سماه: (التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات المودودي وسيد قطب)، وسماه في الأردية: (التفسير الجديد للإسلام)، لكن الكتاب حورب وغُيِّب، فلا تجد من أهل العلم وطلابه من سمع بهذا الكتاب ـ بله أن يكون قرأه ـ إلا القليل النادر جدًّا.
لقد كان هذا الكتاب ثمرة ذوقٍ ديني صحيح، وحماسة إيمانية قوية، ووعيٍ حضاري موفَّق، وحدس ذكي صادق بالنتائج الخطيرة للتفسير الجديد للإسلام، مما حمله على تأليفه نصحًا للأمة، وإبراء للذمة، وعبَّر عن ذلك في مقدمته فقال:
(وأفزعته اتجاهات فكرية وفهوم وتفسيرات للدِّين بدتْ طلائعها في الحديث والكتابة، والفكر والتأليف، والعمل والتطبيق، وخاف أن تنشأ طبقة أو مجتمع فيه عدد كبير من الشباب الأذكياء المثقَّفين، والعاملين لمجد الإسلام المخلصين، من أصحاب الهمَّة العالية، والنظر البعيد، والإيثار وروح التضحية في خدمة الإسلام والمسلمين؛ على منهج يختلف عن المنهج الإسلاميِّ الأوَّل في الرُّوح والدَّوافع، والنَّفسيَّة والعقليَّة، والأهداف والغايات، والمثل والقيم، ويُضعف ما جاهد له الرَّسول وأصحابه، من إخلاص الدِّين لله، والعمل للآخرة، وروح «الإيمان والاحتساب» المسيطرة على الحياة كلِّها، السَّارية في الأعمال والتصرُّفات بأسرها، ويتحول هذا الكفاح إلى مجرَّد عمليَّة تنظيم جماعيٍّ، أو محاولة الحصول على الحكم والسُّلطان للمسلمين، وقد يكون تحوُّلًا لا رجعة بعده إلى الأصل والمصدر، كما جُرِّب ذلك مرارًا في تاريخ الأديان والفرق، والدَّعوات والحركات، فأقبلنا ـ مضطرِّين عَلِم الله ـ على التنبيه على هذا الخطر ـ ولو كان غامضًا أو بعيدًا ـ فالحبُّ يبعث على الإشفاق، والنُّصح يدفع إلى الإنذار).
لله درُّك يا أبا الحسن؛ فقد صدق حدسك، وأصاب تقديرك، ونلت شرف السبق في النصح والتحذير من (التحريف العالمي للإسلام)، فقد تحوَّل الفكر الحركي إلى فتنةٍ عامة على مستوى الأمة؛ فتنةٍ ولا أبا الحسن لها!
لقد بذل الندوي رحمه الله جهدًا قيِّمًا مشكورًا ـ في كتابه هذا، وفي سائر كتبه ـ في فضح التفسير الجديد للإسلام بأنه مشروع لإعمار الأرض وإقامة المدينة الفاضلة، وتجريده ـ بالتدريج ـ من حقائقه الدينية والتعبدية والعقيدية، وبيَّن أن ذلك ينطوي على افتتان بالفكر الغربي وفلسفاته، لهذا جعل الندوي أكبر همِّه في كثير من محاضراته وكتاباته في بيان حقيقة العبادة، والغاية من الدين، وتجريد الدعوة من المقاصد المادية والمكاسب الدنيوية، ونقد الفكر الغربي، وهدم أصوله القائمة على المادية والأنانية والنفعية.
إن تراث الندوي رحمه الله منجم عظيم يمكن الاستفادة منه في جهاد العصر ضد التحريف العالمي للإسلام، فأنصح إخواني من العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله بالرجوع إليه، واستخراج كنوزه، خاصة أن للندوي رحمه الله شهرة واسعة، ومكانة رفيعة في العالم الإسلامي، ولن يجرؤ أحد من الحركيين على وصفه بتلك الأوصاف التي يطلقونها على العلماء الربانيين الذين يجهرون بحقائق الدين كما وردت في الكتاب والسنة، أولئك: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ}؛ فيتطاول عليهم السفهاء باتهامهم بالجهل بالواقع والسياسة وبقلة الفهم والرجعية والتخلف والخوف من الحكام؛ فقد جئناكم بمن تشهدون له ـ مرغمين ـ بالمعرفة التامة بالدين والسياسة والفكر والفلسفة والتاريخ؛ فأنَّى تؤفكون؟!
ووفاء للندوي رحمه الله؛ فإنني أعكف الآن على إخراج كتابه: (التفسير السياسي للإسلام) في طبعة جديدة؛ إحياء له، وتنويهًا بأهميته، واعترافًا بفضله، وسأنصرف بعد ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ إلى وضع دراسة موسعة عن التفسير السياسي والنفعي للإسلام؛ لعلِّي أنال شرف المشاركة في جهاد العصر، وبالله تعالى التوفيق، ومنه العون والتسديد.
وكتبه: أبو مَسْلَمَة عبد الحق التركماني
بريطانيا: 9 رمضان 1432هـ
- لا يوجد تعليقات بعد
