الرد على شبهة في استباحة دماء العاملين في المنظمات الخيرية والإغاثية
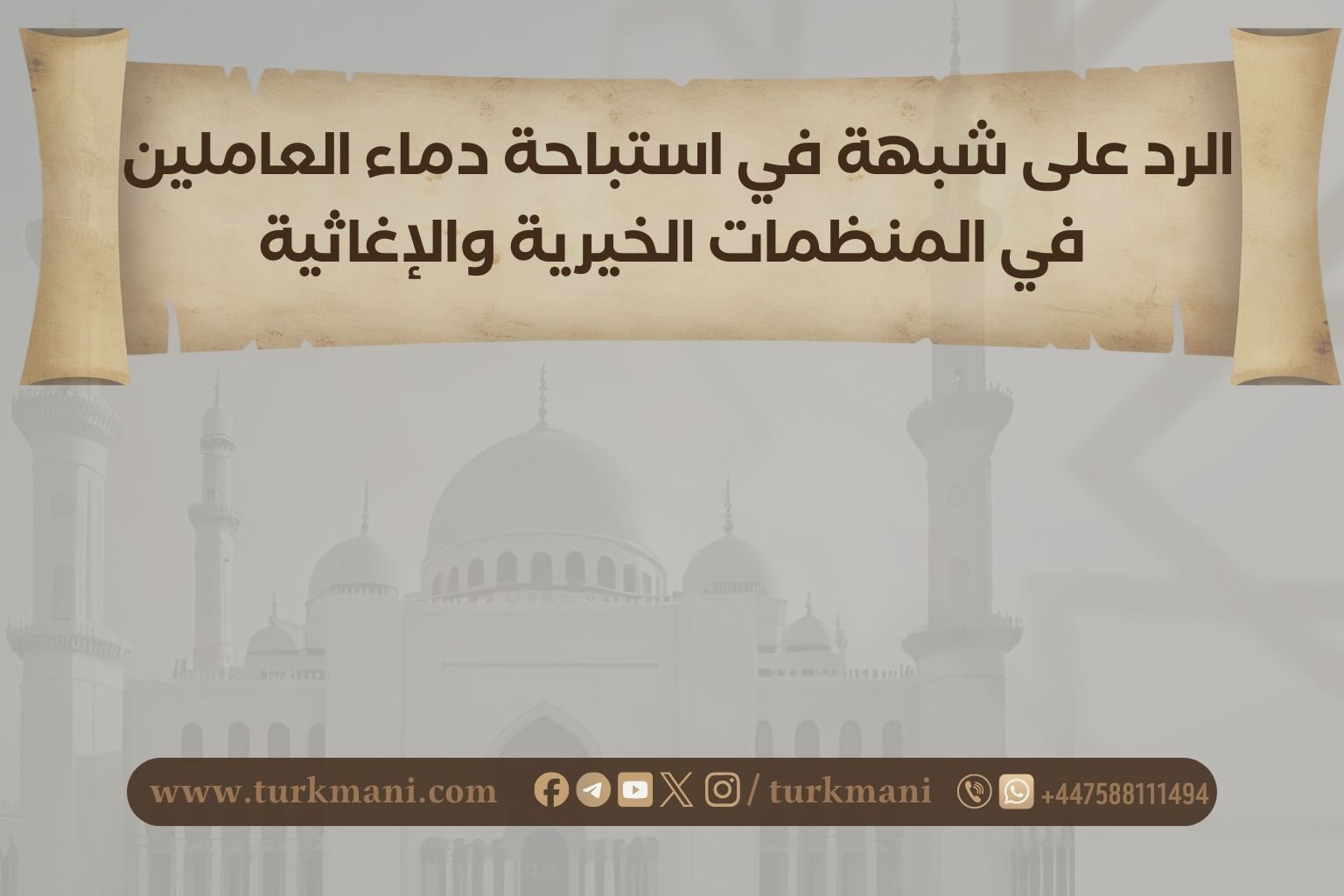
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
دين الإسلام دين الحق والخير، والعدل والرحمة، والوفاء بالعهود والمواثيق، وقد ابتلي كثيرٌ من المسلمين بمخالفة الأحكام الشرعية، والأخلاق النبوية، بسبب جهلهم بالقرآن والسنة، وبُعدهم عن الفقه الصحيح، واتباعهم لأهل الانحراف في الفهم، والغلو في الدِّين؛ فارتكبوا جرائم شنيعة، فيها تشويه لصورة الإسلام والمسلمين، وصدٌّ عن دين الله الحقِّ، ونقض للعهود والمواثيق التي أمرنا الله بالوفاء بها، وحذرنا من نقضها، ومن الغدر والخيانة.
ومن صور الانحراف الخطير في فهم الشريعة، والوقوع في الغدر والظلم والخيانة؛ ما يرتكبه الغلاةُ المتطرفون باسم الإسلام من الاعتداءِ على العاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية، بأخذهم رهائن وأسرى، ثم المتاجرة بهم بأخذ الفدية، أو استخدامهم أدوات للصراع بقتلهم، وقطع رؤوسهم، وتصوير ذلك ونشره؛ لبث الذعر والخوف بين الناس. وآخر ذلك: قيامهم بخطف المواطن البريطاني المسالم: ألين هامينك Allen Hamming، الذي ذهب إلى سوريا لإغاثة المنكوبين، ومساعدة المحتاجين. ولا شكَّ أن هذا الرجل يستحقُّ الشكر والامتنان، ولا يجوز أن يقابل إحسانُه بالغدر والخيانة، فكيف بقتله ظلمًا وعدوانًا؟!
فهؤلاء القتلة المجرمون لم يتمسكوا بالشريعة الإسلامية، ولا عرفوا الأخلاق النبوية، فتجردوا من الدين والأخلاق، ورغم ذلك؛ يريدون أن ينسبوا أفعالهم الشنيعة إلى دين الإسلام، ويبلِّغُوا الناس رسالة مفادها: أن دين الإسلام دين غدر وخيانة ودناءة أخلاق وتلذذ بقطع الرؤوس وسفك الدماء!
وكل من درس القرآن والسنة، وكان على علم بالفقه والشريعة؛ يعلم يقينًا أن هؤلاء الخوارج الذين حذَّرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذَّابون مفترون على الشريعة، فهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: «شرُّ الخَلْق والخليقة»، لأنهم يحرِّفون دين الإسلام، ويبدِّلون شرع الله عزّ وجلّ.
وقد أطلعني بعض الإخوة الأفاضل على شبهة من الشبهات التي يتداولها أولئك الأشرار، يخدعون بها الشباب المسلم، ويصورون لهم أنهم يتبعون القرآن والسنة.
وتلك الشبهة: هي الاحتجاج بالحديث الذي أخرجه مسلم (1641) عن عمران بن حصين، قال: كانتْ ثقيفُ حلفاءَ لبني عقيل، فأسرتْ ثقيفُ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء [هي ناقة]، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الوثاق، قال: يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال ـ إعظاماً لذلك ـ: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف»، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا، فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟»، قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنتَ تملك أمرك؛ أفلحتَ كل الفلاح»، ثم انصرف فناداه، فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إنِّي جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: «هذه حاجتك»، ففُدِي بالرجلين.
فقالوا: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الرجل أسيرًا، مع أنه لم يكن من المحاربين، بل أسره لمجرَّد كونه من قبيلة بني عقيل، وهذا معنى قوله: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف»؛ يعني: أخذه بذنب غيره. قالوا: فيجوز بهذا أن يؤخذ هذا المواطن البريطانيُّ أسيرًا لكونه من الدولة المحاربة لهم.
والجواب عن هذه الشبهة، باختصار من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن سياق الحديث يدل بوضوح على أن ذلك الرجل كان كافرًا حربيًّا، ولم يكن له عهد ولا أمان مع المسلمين، ومَن ادَّعى أنه كان مسالمًا، مأتمنًا، ومع ذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرًا؛ فقد اتَّهم النبيَّ بالغدر والخيانة والظلم! لهذا قال العلامة أبو عبد الله محمد بن علي المازري المالكي (ت: 536هـ) رحمه الله في «المعلم بفوائد صحيح مسلم» 2/361:
«مما يُسئل عنه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «أخذتك بجريرة حلفائك»؛ فقال: كيف هذا والله تعالى يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]؟! وللناس عن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه يمكن أن يكونوا عوهدوا على ألا يتعرضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا هم ولا حُلفاؤهم، فنقض حلفاؤهم العهد، وَرَضُوا هم بذلك، فاسْتُبِيحوا لأجل ذلك.
والثاني: أنهم كفار لا عهد لهم، والكافر الذي لا عهد له يُستباح، وإن لم يفعل حلفاؤه شيئًا.
والثالث: أن يقال في الكلام حذفٌ، ومعناه: أخذناك لنفادي بك من حلفائك.
ويحتمل عندي جوابًا رابعًا، وهو: أن يكون جوابه على جهة المجازاة والمقابلة، لأنه لما قال له: بِمَ أَخذتني؟ وبِمَ أَخَذْتَ سابقة الحاجّ؟ لأن ذلك كان معظَّمًا عندهم قال صلى الله عليه وسلم له: «أَخذتك بجريرة حلفائك»؛ لأنهم أيضًا كانوا يطالَبُون بِعُهْدَةِ الحلفاء. هذا الأظهر من عادتهم، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان عنده مستباحًا، فلما ذكر له سابقة الحاجّ ذكر له جريرة الحلفاء على جهة المقابلة على أصلهم».
الوجه الثاني: إذا تبيَّن هذا، وعُلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذه أسيرًا على سبيل المجازاة والمقابلة للتعامل الذي كان معروفًا بينهم؛ فإنَّ المعروف الآن بين الدول والأُمم: أنَّ الأشخاص الذين يدخلون مناطق الحروب بهدف الإغاثة الإنسانية أو الصحافة والإعلام؛ لا يجوز التعرُّض لهم بالأذى، ويجب المحافظة على حياتهم. هذا متفق عليه بين جميع البشر اليوم. فالواجب على المسلمين أن يعاملوا الناس بهذا العُرف المقرَّر عالميًّا، ولا يقابلوه بالغدر والخيانة.
الوجه الثالث: أنه لو فرضنا أن هذا الشخص المدني المسالم؛ كان جنديًّا محاربًا للمسلمين، لكنَّه دخل بينهم هذه المرَّة بصفة مختلفة، وهي أنه عضوٌ في جمعية إغاثية، وبقصد مختلف، وهو تقديم العون والمساعدة؛ فإنَّ حكم الشريعة في هذه الحالة، وباتفاق جميع الفقهاء: أنه يستحقُّ بهذه الصفة والقصد «الأمان»، فيكون معصوم الدم والمال، ولا يجوز الاعتداء عليه، بل يجب على المسلمين حمايته، والدفاع عنه، حتى لو أدَّى ذلك إلى القتال من أجل المحافظة على حياته، فيُعرِّضُ المسلمُ نفسه للهلاك وفاءً وحفظًا لعقد الأمان الذي في ذمَّته لذلك الكافر، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «إنّ مَن كان في الذِّمَّة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة» نقله القرَّافي في كتابه: «الفروق» 3 /14.
وهذا الذي ذكرناه هنا: مبنيٌّ على أصل عظيم، اتفق عليه فقهاء الإسلام؛ وهو أن «استحقاق الأمان» لا يحتاج إلى كتابة وتوثيق، وليست له صيغة محددة، ولا شروط مشدَّدة، بل يثبت الأمان بكل قول أو فعل أو تصرف دالٍّ عليه، وذلك تعظيمًا لشأن الأمان، وتغليبًا لجانب حَقْنِ الدِّماء. وللفقهاء كلام كثيرٌ في تقرير هذا، يطول المقام بذكره، وقد ذكرت جانبًا منه في كتابي: «الدخول في أمان غير المسلمين»، لهذا أكتفي بأثرٍ واحد عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فيه تذكرة قوية، وعبرة بليغة لأولي الألباب:
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (34082) بإسناد صحيحٍ، عن أبي عطيَّة قال: كتب عُمرُ إلى أهل الكوفة أنَّه ذُكِرَ لِي أن «مَطَّرْس» بلسان الفارسية: «الأَمَنَةُ»، فإن قلتموها لمن لا يفْقَه لسانَكم فهو أَمْنٌ.
وأخرج ابن أبي شيبة (34085) أيضًا عن أبي وائلٍ قال: أتانا كتابُ عُمرَ ونحن بخانَقِينَ [وهو موضع في العراق، كان فيه حربٌ بين المسلمين والفرس]: إذا قال الرَّجلُ للرجل: «لا تدْهَلْ!»؛ فقد أمَّنَه، وإذا قال: «لا تخف!»؛ فقد أمَّنه، وإذا قال: «مَطَّرْس»؛ فقد أمَّنه. قال: فإنَّ الله يعلمُ الألسنةَ.
فهذا هو الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فربَّى عليه صحابته الكرام وخلفاءه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.
بقلم: عبد الحق التركماني
رئيس مركز دراسات تفسير الإسلام
(نشر في سنة : 2014)
المصدر:
http://www.al-jazirah.com/2014/20141006/rj8.htm
- لا يوجد تعليقات بعد
