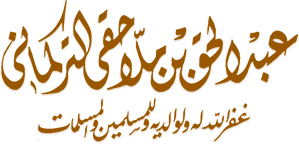خطبة الجمعة يوم النحر 1430

خطبة الجمعة يوم النحر 1430
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، له الحمد على عظيم مِننه وواسع رحمته وكرمه، أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينًا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له إله الأوّلين والآخرين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين.
عباد الله: هذا يوم عظيم من أيام الله، إنَّه يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى المبارك. أسأل الله سبحانه أن يبارك عليَّ وعليكم هذه الأيام، ويتقبَّل منا الطاعات، ويغفر الزلات، ويرفع الدرجات.
عباد الله: قد اجتمع عليكم في هذا اليوم عيدان، عيد السنة الأكبر وعيد الأسبوع، وقد صلينا صلاة عيد الأضحى، وها نحن هنا قد اجتمعنا ثانية لخطبة الجمعة وصلاتها. وقد قرأتُ في ركعتي صلاة العيد سورة الأعلى وسورة الغاشية كما هي سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي السنَّة في القراءة في ركعتي الجمعة التي سنصليها الآن؟ لقد أخبرنا الصحابي الجليل النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه عن هذه السنة فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب «سبح اسم ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية» قال النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين) «أخرجه الإمام مسلم في جامعه الصحيح» (878). إذن هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقرأ بالسورتين في ركعتي العيد، فلما اجتمع نفسه ذاك الجمع في نفس اليوم لصلاة الجمعة، خلف نفس الإمام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إذا به يعيد قراءة تلك السورتين.
فكم هو حريٌّ بنا إخوة الإيمان: أن نقرأ في تفسير هاتين السورتين حتى نتدبّر في معانيهما، ونتأمل في مقاصدهما، لعلنا ندرك فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في اختياره قراءة هاتين السورتين في مجمع عظيم وموقف جليل ومناسبة بالغة القدر والأهمية.
لقد تضمنت السورتان من أصول الاعتقاد وحقائق الإيمان ومعاني الموعظة ما هو كفيل بهداية العقول، وإحياء القلوب، وتزكية النفوس، وتذكرة أولي الألباب. فسورة الأعلى اُستفتحت بتسبيح الله تعالى لأنّه الأعلى والأجلُّ، المنزّه من كل عيب ونقص، هو الأعلى في ذاته، والأعلى بأسمائه وصفاته، وهو الأعلى بقوته وقهره {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ}. ثم نبَّه ربنا سبحانه على ما في خلقه من دلائل عظمته وجلاله، ثم جاءت البشارة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنّ الله تعالى سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، ثم البشارة الثانية بأنّه سبحانه سييسره لليسرى، أي: يسهل عليه افعال الخير وأقواله ويجعل ما شرعه له سهلًا سمحًا مستقيمًا عدلًا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عُسر، فليس على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلا أن يُذكِّرَ إن نفعت الذكرى، أي: حيث لم تنفع الذكرى، ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يوضع عند غير أهله، فإذا أتى الداعي ما عليه فالمدعو هو الذي يتحمل المسئولية، وعليه التَبِعة في الانتفاع بالتذكير والموعظة، أو الانكباب عن الحق والضلال عن السبيل.
ثم تأتي خاتمة هذه السورة بذكر شرط الفلاح، تسلية النفس باتباع ما أنزل الله تعالى على رسوله، وتطهيرها من الأخلاق الرذيلة، وإقامة الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالًا لشرع الله، والذي يعيق هذه التزكية وهذه الطاعة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة، أمّا من علم أنَّ الآخرة خيرٌ وأبقى لأنَّ الدنيا دنيّة فانية والآخرة شريفة باقية خالدة فكيف يُؤثِرُ عاقل ما يفنى على ما يبقى؟! ويهتم بما يزول عنه قريبًا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلود {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)} [الأعلى].
إنَّ هذه الموعظة وهذه التذكرة وهذه المعاني الجليلة هي في الصحف التي أنزلها الله تعالى على الرسولين العظيمين إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. فدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي امتداد لدعوة الأنبياء والرسل من قبله، رسالتهم واحدة، غايتهم واحدة وهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى وحده {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٣٦)} [النحل]، {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)} [الزمر]، {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)} [الشورى]. يا له من معنى عظيم أن يدرك المسلم أنّه يتبع أنبياء الله جميعًا، وينتمي إلى دعوة امتدادها إلى أول إنسان وأول نبي على وجه الارض آدم عليه الصلاة والسلام.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبِّتنا على دينه وأن ويبارك لنا في أيامنا وينفعنا بالقرآن العظيم والسنَّة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.
الخطبة الثانية:
الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، إعزازًا لمن آمن به وأقرّ، وإرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
عباد الله: أمّا سورة الغاشية وهي من أسماء يوم القيامة فاستُفتحت بوصف العاقبة المخزية لمن عمل في الدنيا بتعب ونصب لكن على غير هدى واتبع غير الحق، لهذا يلقى يوم القيامة نارًا حامية شديدة الحر، شرابه من ماء بلغ منتهى الحرارة، وطعامه من شجر في النار. أمّا اهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم، واستنارت وجوههم، وسُرّوا غاية السرور لسعيهم الذي قدّموه في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، راضيةً أنفسهم إذ وجدت ثواب أعمالها مدّخرًا ومضاعفًا.
هكذا منهج القرآن إخوة الإيمان: يقرن بين ذكر أهل النعيم وأهل العذاب، ويعقب ذكر صفة جهنم بذكر صفة الجنة، حتى يجتمع الترغيب والترهيب، ويكون في قلب المؤمن الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ثم يأمر الله تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدَّالة على قدرته وعظمته، ففيها شواهد الحق على ربوبيته وكمال صفاته، مما يوجب على العقول الخضوع له بالتعظيم والإجلال، والتوجه إليه بالقصد والسؤال.
وتأتي خاتمة سورة الغاشية للتقرير مجددًا بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا الدعوة والتذكير {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١)} أي ذكِّر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنّك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله ولم تُبعث مسيطرًا عليهم مُسلَّطا مُوكَّلًا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك ما يعملون، كما قال ربنا سبحانه: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥)} [ق]. {إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣)} أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله {فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤)} العذاب الشديد الدائم. {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥)} أي: يوم والبعث والنشور وجمعهم في يوم القيامة. {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)} فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. وفي هذا تسلية للداعي الذي يجد الإعراض والاستكبار من المدعوّين، فما عليه إلا البلاغ وإلى الله المرجع والمآب.
إذن إخوة الإيمان: هذه هي المعاني الكلية، هذه هي الأصول العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها هذه الآيات الكريمات، مُنبِّهًا على ما فيها من المعاني الجليلة، ويستغل فرصة الاجتماع، لاجتماع أمور عظيمة وشعائر جليلة، فرصة إقبال القلوب على الله سبحانه تعالى وانتباه المؤمنين وحرصهم عند ذلك ينبههم على هذه المعاني الجليلة. وكان القوم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عربًا أقحاح يفهمون الكلام ويعرفون معاني القرآن من غير تفسير ولا كثير تكلفة، فاحتجنا أيها الإخوة: احتجنا الى التفسير والفهم والتدبر حتى نعي هذه الآيات الكريمات، ولا تكون قراءتنا لها مجرد عادة سارية من غير تدبُّر وتفكُّر وتفقُّه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، ويعلِّمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علَّمنا
- لا يوجد تعليقات بعد